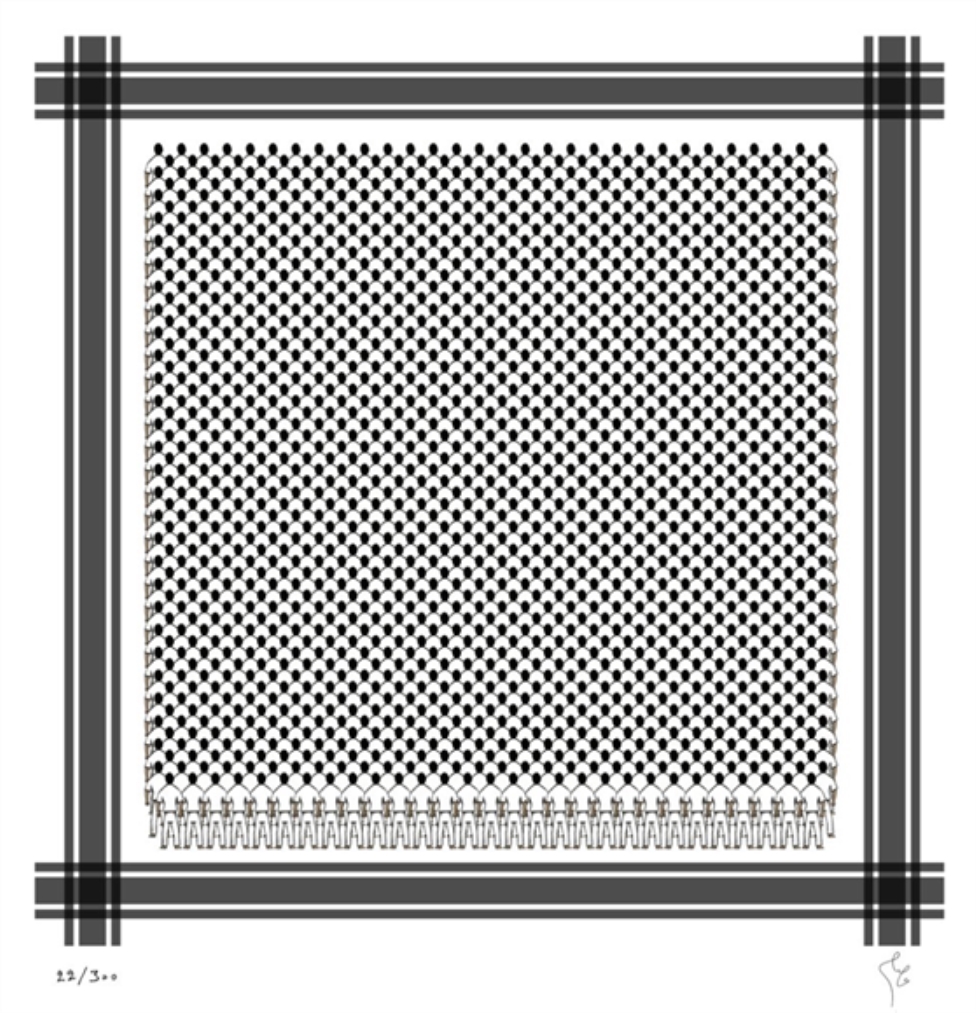منذ أن انطلقت المقاومة الفلسطينية المسلحة، ووضعت حرب التحرير الشعبية تصوّراً مركزياً لها، كانت تدرك منذ البداية أن اعتمادها على حاضنتها الشعبية هو السبيل الوحيد، لإطالة أمد هذه الحرب، في ظل اختلال موازين القوى بينها وبين دولة الاحتلال. ولم تشذ مختلف القوى الفلسطينية عن هذه القاعدة. الحاضنة الشعبية مخزنها الأساس، فيه ومنه، تتزود بكل أشكال الدعم المادي والمعنوي. وعندما كانت الثورة خارج حدود البلاد، كانت المخيمات الفلسطينية تمثّل رصيداً إستراتيجياً لا ينضب، فهي الشاهد على فعل النكبة، ومنها تتخرّج أفواج الفدائيين لتلتحق بها.من هنا عمل الاحتلال على محاولة ضرب الحاضنة الشعبية، عبر سلسلة من عمليات القصف والتدمير المتواصل، في محاولة منه لقطع هذا الامتداد الأصيل للثورة، ولم يكتف بذلك، بل صبّ ماكينته الإعلامية ودعايته النفسية، على إحداث الوقيعة بين الثورة وحاضنتها الشعبية. هذا السلوك الدائم ما زال في وعي الاحتلال، ولا يملك غيره، فهو لا يمثل نموذجاً حضارياً جاذباً، ولا يمتلك القدرة على ذلك. في الأراضي المحتلة عام 1967، ومع تفجّر الانتفاضة الكبرى، تنوّعت كل وسائل العقاب الجماعي ضد الأهل في غزة والضفة، في محاولة منه مرة أخرى لإحداث عملية الفصل بين قوى المقاومة وحاضنتها الشعبية، معتمداً على تكتيك الحصار وتقطيع الجغرافيا، ومنع التواصل بين مكوّناتها، إضافة إلى قطع الكهرباء والماء عن الكثير من المناطق وإن كان بوتيرة أقل مما يحدث اليوم على أرض غزة، فالاحتلال يعتقد أن هذا الأسلوب هو الكفيل في إخماد المقاومة، عبر دفع الكل الفلسطيني إلى الاعتقاد الجازم، بأن لا جدوى من المقاومة، وأن محصّلتها العملية صفرية الدرجة.
ماذا تغيّر في هذه الحرب؟
مع لحظة 7 أكتوبر المجيدة، وظهور عملية الإسناد الشعبي لعناصر المقاومة أثناء اقتحام ما يُعرف بغلاف غزة، أخرج الاحتلال كل خبثه دفعة واحدة، ورماه دفعة واحدة، كخطة عمل رأى أنها متناسقة، وأنها ستؤدي الدور المطلوب. لكن هذا الخبث المخبّأ كان أكبر من حدود العقاب الجماعي، وأقوى كذلك من محاولة الفصل بين المقاومة وحاضنتها الشعبية، بعد أن أعلن الحرب على الجميع من دون تفريق بين الجسم العسكري والمدني. وعلى العكس، أعلن منذ اللحظة الأولى للعدوان، وبصورة واضحة، قطع إمدادات الغذاء والدواء والماء والكهرباء، وطلب من سكان شمال غزة النزوح القسري إلى جنوب قطاع غزة، تحت القصف الجوي الذي لم يسلم منه شيء، وأعلن بوضوح أن حربه المفتوحة هدفها النهائي تهجير سكان القطاع إلى سيناء.
كل تصريحات القادة والساسة والعسكريين والأمنيين، كانت منصبّة جميعها في هذا الاتجاه، في حين عملت الماكينة الإعلامية على الترويج لهذا الطرح. و«الغريب» هنا تساوق الإعلام الغربي مع الرواية الصهيونية بكل حذافيرها، والتي لا تزال حتى هذا الوقت تبرر للمحتل كل جرائمه المرتكبة على أرض غزة، بذريعة أن الاحتلال لا يملك غير هذا الخيار.
التفعيل في أيام الحرب
مع الأيام الأولى للحرب، وقد شهدت أشرس حملات القصف الجوي والبري والبحري، الذي طاول مختلف المنشآت المدنية في قطاع غزة، تحديداً في شمال القطاع، ليفرغه من السكان. ومع فشل المحاولة الأولى من تحقيق أهدافها، رغم سقوط آلاف الشهداء والجرحى وتدمير أكثر من 50% من الأبنية السكنية، لجأ الاحتلال إلى التركيز على تدمير المستشفيات بعد ربطها مباشرة بدائرة الفعل العسكري، محاولاً الترويج بأنها مراكز لعمليات المقاومة. وكانت ذروة هذا الفعل قد تركّزت في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ورغم ادّعاءاته التي أعلنها قبل هذا الاقتحام، فإن روايته سقطت مباشرة بعد فشله في إثبات أي ادّعاء. ومع ذلك واصل مسعاه في الإجهاز على كل المؤسسات الطبية العاملة في شمال القطاع، عبر إخراجها عن الخدمة. كل هذا ولم يتمكّن من إحداث الشرخ بين المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية، فلجأ في الأيام الأخيرة إلى أساليب أكثر خسّة، فالقاعدة الأولى في عمله تقول إن ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة، لهذا لجأ إلى اقتحام المدارس واعتقال آلاف النازحين، وقام بعرضهم على الإعلام بعد أن جرّدهم من ملابسهم. وقد أفادت شهادات الذين أُفرج عنهم، بأن هدف الاحتلال من هذا الفعل هو الحطّ من كرامتهم وانتهاك إنسانيتهم، كما أن شهادات بعض النساء أفادت بأن عناصر جيش الاحتلال قاموا بتهديدهن بالاغتصاب.
الناظر إلى السلوك الوحشي لجيش الاحتلال، والذي يحدث بوتيرة متسارعة، يشي بأن جيش الاحتلال تعرّض لانتكاسة حقيقية في الميدان، والشاهد عليها، التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن آلاف القتلى والجرحى في صفوفه. مقابل ذلك ليست هناك بادرة واحدة على انكسار المقاومة أو تراجعها. فالبحث عن صورة نصر حقيقي أو إنجاز عسكري فعلي، دفعه إلى محاولة صناعة متخيّلة لهذا النصر وهذا الإنجاز، عبر سلسلة من الأكاذيب التي يروّجها يومياً في وسائل إعلامه.
هل الحاضنة الشعبية بخير؟
بالتأكيد، إن حجم المعاناة والألم والظروف المعيشية غير الإنسانية التي تحياها الحاضنة الشعبية للمقاومة، لا يمكن وصفه، ولا يمكن أن يطاق. ففي التواصل مع العديد من الأصدقاء الذين يسكنون في مدينة غزة وفي مخيم جباليا حتى هذا اللحظة، يتحدثون عن مجاعة حقيقية ونقص في كل شيء، من الغذاء والماء والدواء وفقدان المأوى، خاصة في الأيام الأخيرة التي عمل فيها جيش الاحتلال على تهديد المقيمين في مدارس الإيواء والطلب منهم الإخلاء تحت تهديد السلاح، لدفعهم للتوجه نحو جنوب القطاع، وصولاً إلى تفريغ المدينة ومخيماتها من السكان. ومن المفارقة هنا أن معظم مسؤولي الاحتلال يتهمون حماس بمنعهم من التوجه جنوباً، فيما يعلنون جهاراً أن لا أحد سيعود إلى الشمال حتى بعد انتهاء الحرب.
ما الذي يجعل من الحاضنة الجائعة صامدة حتى هذا الوقت؟
من البديهي أن هذه الحاضنة هي المالكة الحقيقية لهذا المكان، ومن الطبيعي أن تحافظ على البقاء فيه، ومن البديهي أيضاً أن تلك الحاضنة تشاهد الفعل البطولي الأسطوري لرجال المقاومة في شوارع غزة ومخيماتها، وهي تفتك بالآلة العسكرية أمامها، فهي الشاهد الفعلي وبالعين المجرّدة على هذا الالتحام، بل باتت تدرك أنه كلما تصاعدت المقاومة وكبّدت الاحتلال الخسائر في الرجال والعتاد، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الضغط عليها، محاولاً ابتزاز المقاومة بأهلها وشعبها، وهذا دليل فعلي على هشاشة وعي المحتلين. المعادلة الفعلية والحقيقية تقوم على الشكل التالي، كلما زاد الاحتلال من جرائمه تجاه تلك الحاضنة، صعّدت المقاومة من فعلها، وليس العكس الذي يعتقده الاحتلال، ولهذا نرى حالة التخبط الفعلي الذي يعيشه الاحتلال في هذه اللحظات، فهو بكل بساطة جرّب كل ما لديه من وسائل غير مشروعة، وخاض حرباً مفتوحة، بعيدة عن أي قيود قانونية، أو حتى الحد الأدنى من الأخلاق. جرّبها جميعها ولم يصل إلى من يريد، فالمقاومة موجودة وتفعل فعلها كل يوم، والحاضنة الشعبية على أرضها، ولأن مكوّنات الطرفين واحدة، وكلتاهما صنيعةُ الآخر، فهما ثقافة الحرية، ورفض الاحتلال، ثنائية تمضي في طريق واحدة، طريق الانتصار.
صحيح أن مصاب غزة كبير جداً ولا يحتمله العقل البشري، والأصح أيضاً أن غزة الصغيرة بمساحتها وإمكاناتها المحدودة، المحاصرة منذ عقدين، أثبتت أنها قادرة على تدفيع الاحتلال الثمن، وقد دفع، فمن دون أثمان لا ولن يرحل هذا الاحتلال.