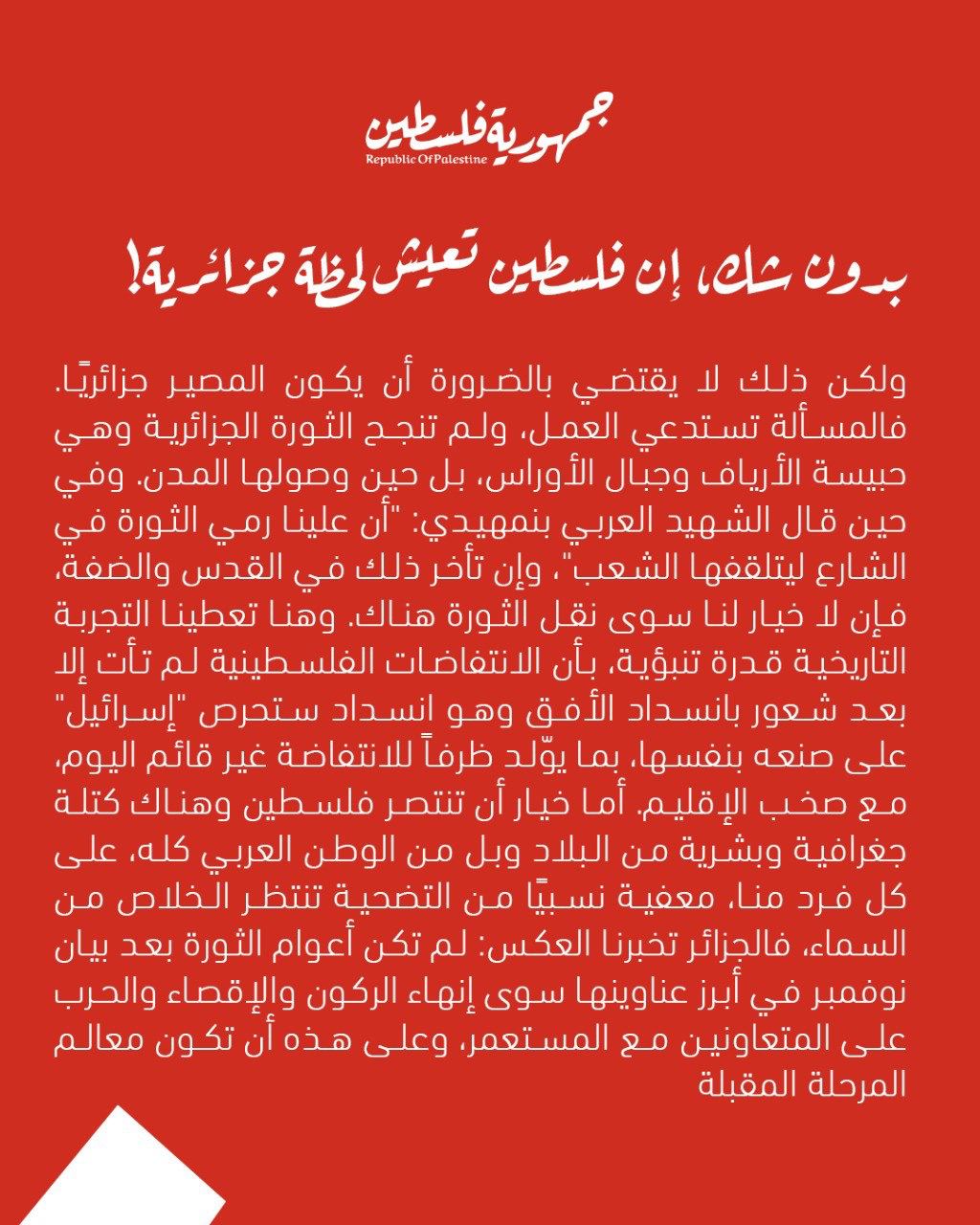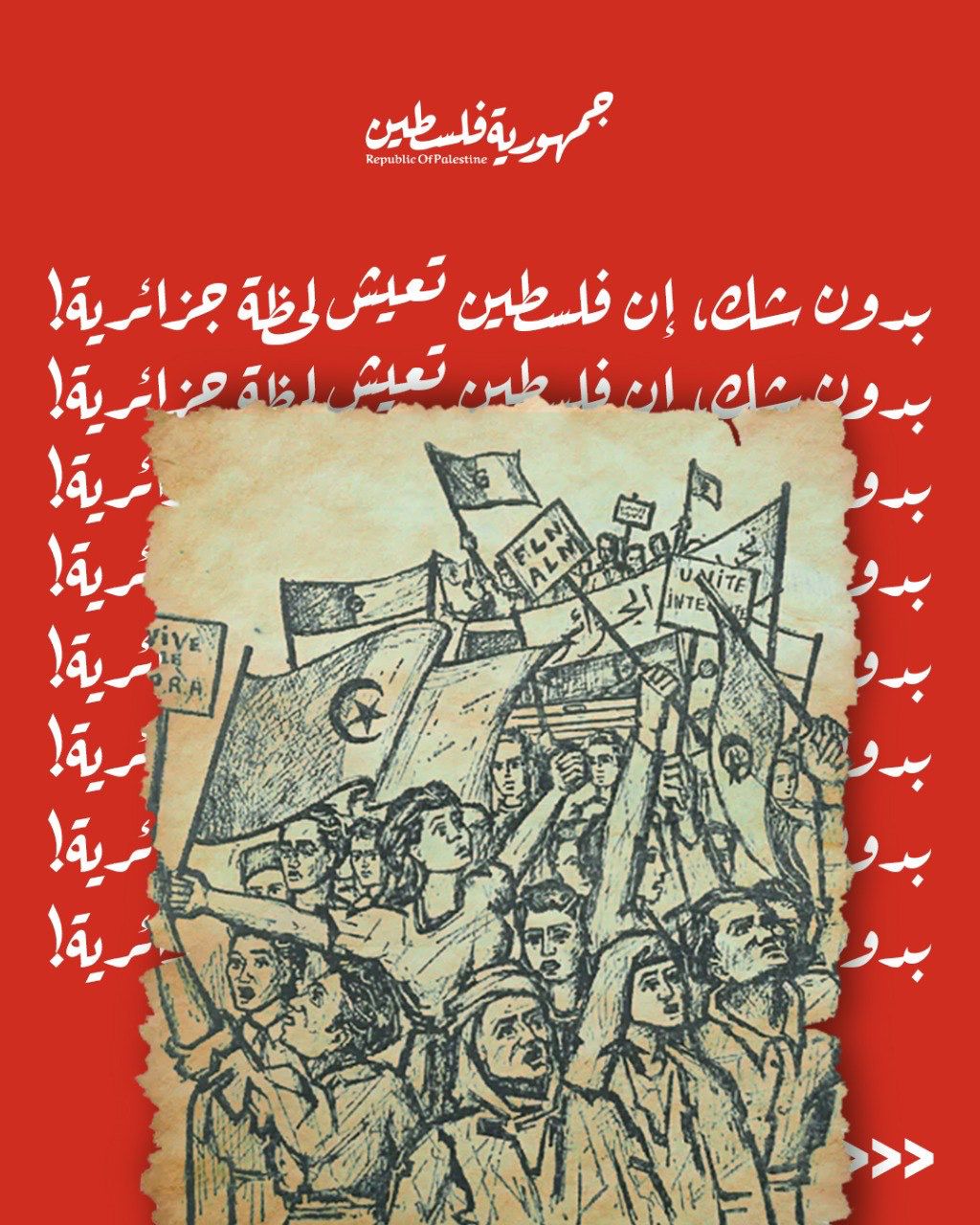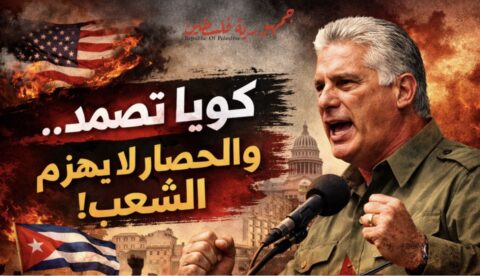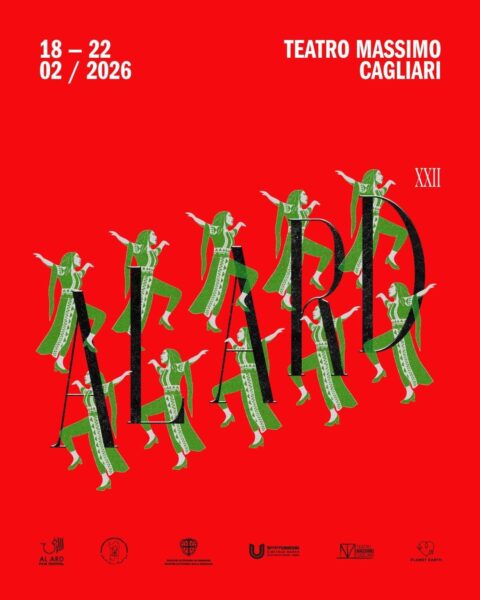بقلم: موسى السادة
ليل الإثنين المصادف للأول من نوفمبر من عام 1954، شنَّ 1200 مجاهد جزائري هجومًا متزامنًا في مختلف المناطق العسكرية على امتداد خريطة الجزائر. كان عتاد المجاهدين أقل من عددهم، حيث تُقدّر قطع السلاح المتوفرة بأربعمائة، إلا أن عدد عمليات المقاومة وصل إلى ثلاثين عملية، مسفرة عن مقتل 30 مستوطنًا أوروبيًا وجرح 24، وخسائر مادية بملايين الفرنكات الفرنسية.
كان نداء الثورة قد أُعلن قبلها بيوم، 31 أكتوبر، حيث تمت طباعة وتوزيع ما عُرف بـ “بيان الأول من نوفمبر” بين ليل الأحد وصباح ذلك الإثنين، بإشراف من القائد محمد بوضياف، ومن ثم لتبدأ العمليات مع حلول الظلام. ويرجع اختيار هذا اليوم لاعتبارات سياسية وعسكرية، وهي مصادفته لعيد Toussaint La المسيحي، وعطلة نهاية الأسبوع، حيث يذهب ضباط العدو الفرنسي للإجازة.
بعدها بسبعين سنة، وبذات العدد من المقاومين، في صباح السابع من أكتوبر، المصادف لعيد العرش اليهودي، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تكرر الحدث في فلسطين، ولكن بشكله التاريخي الخاص، وتزامنت العمليات العسكرية وبث بيان “طوفان الأقصى” على لسان القائد محمد الضيف.
يرى الدكتور محمد العربي الزبيري في كتابه “الثورة الجزائرية في عامها الأول”، أن أهمية السنين التي تلت بيان نوفمبر لم تكن في أن الثورة كانت مسلحة، فالشعب الجزائري لم يترك السلاح منذ أن داست أرضه أقدام أول جندي فرنسي، ولكن الأهمية بالنسبة للزبيري “ترجع إلى عدد من النتائج الإيجابية التي حققتها في ظرف قصير جدًا بالنسبة إلى تاريخ الشعوب”. وإذا ما نظرنا بلغة الأرقام لما قاله الدكتور، فقد استمر استعمار الجزائر 132 عامًا، بينما احتاجت حرب التحرير والثورة بعد إعلان الفاتح من نوفمبر إلى 7 سنوات، أي قرابة 6% فقط من مجمل تاريخ الاحتلال الفرنسي.
بعبارة أخرى، إن الأحداث تغيّرت بشكل ثوري ومتسارع، وكأنما تم تخصيب التاريخ في جهاز طرد مركزي. ونحن اليوم في العام الثاني للطوفان، يستطيع أي مراقب أن يحسم بأن النتائج الإيجابية للقضية الفلسطينية بدءاً من حجم الهدم الأيديولوجي للصهيونية على مستوى العالم، وتحديداً في الداخل السياسي الأمريكي، حيث تشكل كل من واشنطن ونيويورك، المركز الاستعماري للكيان الاستيطاني (بعد انتقاله من برلين إلى لندن ثم أمريكا)، أي بمثابة باريس للمستوطنات في الجزائر. وأيضاً، خسائر العدو داخل المستعمرة نفسها، في بنيته ومجتمعه وشرعيته ومشروعه، والتي تتجاوز ما تم تحقيقه خلال قرابة الثمانين عاماً من الصراع مجتمعة، إلا أن هذا، وبالتأكيد، لا يكفي.
الأهم أنه لم تكن هذه النتائج لتكون لولا تضحيات كبرى. وفي إطار حرب المصطلحات، لا يجوز هنا، معرفيًا قبل عاطفيًا، الحديث عن “خسائر”، كما يحاول مثقفو الأنظمة العربية تمريره، وذلك عبر تلفيق حسابات ربح وخسارة وكأننا في “بزنس”، لا حركة اجتماعية وتاريخية.
فما نقدمه اليوم هو تضحيات، أي ذلك البذل الذي لا مقابل مادي مباشر له. وهي أكبر الدروس التي يعلّمها أهل غزة للبشرية. فأهل الشهيد أو المصاب المنتشل من تحت الركام لا يتحدث عن كما يفكر مادي ومترف عربي، بأن هناك خسارة للمنزل والممتلكات بحسابات مالية وحصر ذلك من هذا المنظور. بل، والشواهد كثيرة، تراهم مباشرة يتحدثون عن الصمود لحماية مكسب مجتمعي، والإشارة مباشرة إلى رمزية تاريخية كبرى عنوانها المقاومة والأقصى وفلسطين والتحرير، وهذه الأمور لا تُحسب بحساب رياضيات الربح والخسارة، بل هي في نطاق أخلاقي ومعرفي مختلف.
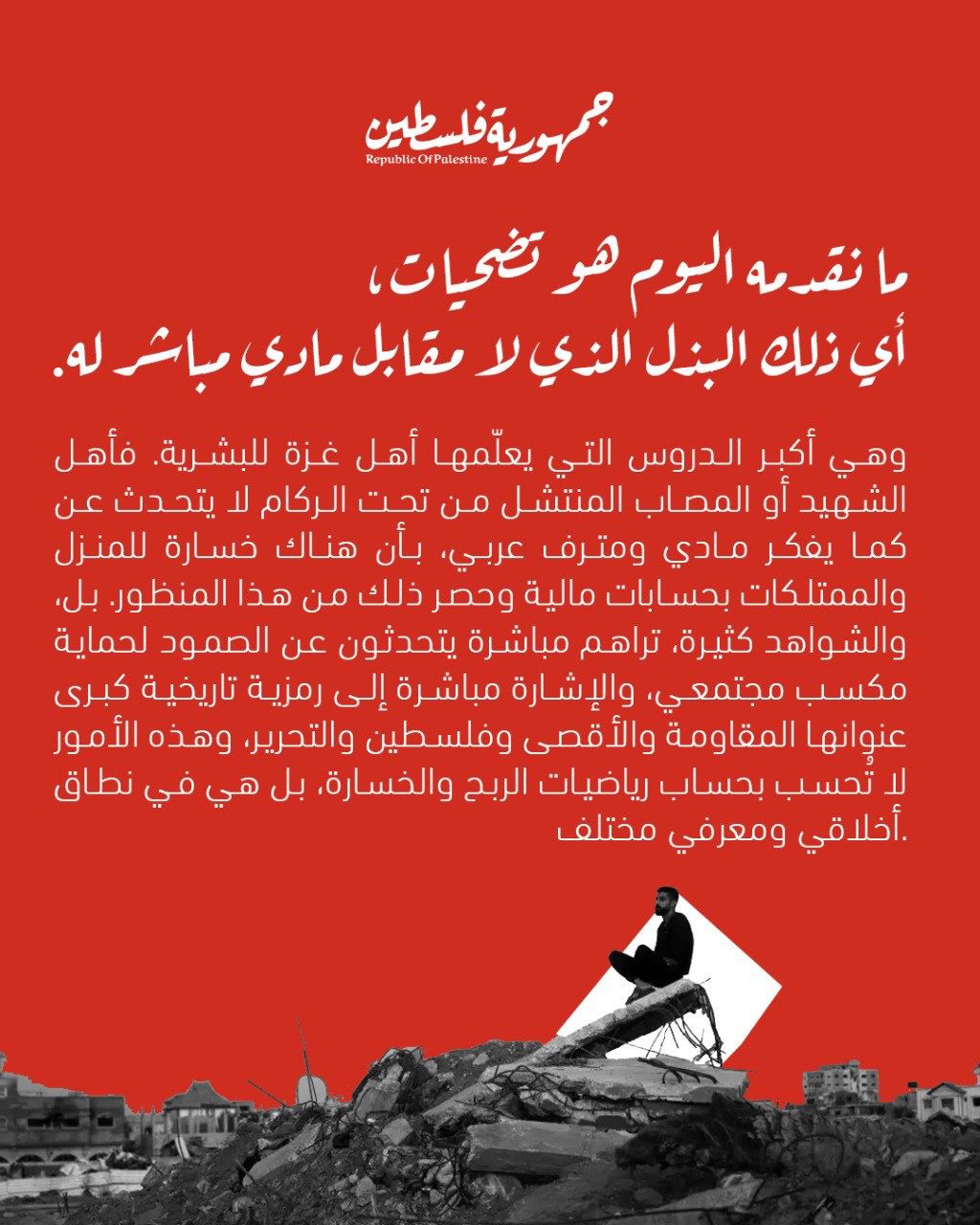
يمكننا الاستدلال أيضًا بأن الأثر النفسي للتضحية الثورية على المرء مختلف عن أثر الخسارة المادية المجردة. وهذا ما لا تفهمه ذهنية الحداثة الأوروبية، ويتم إسقاط حساباتهم النفسية لوقع الخسارة في الأرواح والممتلكات علينا، بل حتى إسقاط إطار علم النفس وآثاره.
وإذ لا يمكن نكران الأثر النفسي المتراكم لأجيال وللأطفال في غزة على وقع جرائم الصهيونية، إلا أنه لا يمكن إغفال أننا نتكلم عن نموذج لا يستوعبه علم النفس الحديث، فالصمود والتضحية والانتماء لقضية تتسامى على الفرد والفردية تُولد أثرًا نفسيًا مختلفًا لا يتقارن مع صدمات من كوارث بيئية أو بشرية، شتّان له، رغم كل الألم.
هذه هي الخلاصة التي توصل لها فرانز فانون في الذكرى الخامسة لبيان الفاتح من نوفمبر، في كتابه: الثورة الجزائرية في عامها الخامس. فوفقًا له، رغم كل العنف الاستعماري الفرنسي على الجزائريين، فإن الأمل لم يؤدِ، بتعبيره، سوى إلى قيام “جماعة روحية تُكون أقوى دعامة لحصن الثورة الجزائرية”، وليس لخسارة وتفكك الشعب والمجتمع. وهنا نفهم قول القائد الثوري عماد مغنية عن الروحية بأنها أصل، في أن من ينتصر في هذه الحركة الاجتماعية والتاريخية هو من يستطيع تحمّل الأذى والصمود أكثر، أي من يستطيع التضحية، مقابل أن الحسابات المالية للربح والخسارة هي منطق جبهة العدو.
المسألة المختلفة اليوم هي تسارع الزمن (بعد لحظة البدء في أكتوبر)، سرعة تعود أحد عواملها إلى سرعة وسائل التواصل والنقل في عصرنا الحالي، ومن الممكن مقاربة ذلك بأن ما احتاج إلى يومين من أول البيان إلى العمليات ضد العدو في الجزائر، أُنجز في ساعات معدودة في فلسطين.
وكذلك عملية الانقلاب في السردية، والتي احتاجت لسنوات في الجزائر، أُنجزت في شهور في حالة “طوفان الأقصى”. إلا أن ما يجعل فلسطين تعيش اليوم “لحظة جزائرية” ليست هذه المحددات والمقارنات الأقرب للرمزية، بل إن اللحظة الجزائرية لفلسطين منطلقة من مقارنة الركائز المادية التي أدت إلى الثورة فانتصارها وتحرير الجزائر، وحقيقة أن النموذجين الاستيطانيين الإحلاليين، الصهيوني والفرنسي، يتشابهان بشكل قلّ التطرق له.
ككل المشاريع الاستيطانية، ينقسم مجتمع المستوطنين والمستعمرين إلى فئات عدة، وتحت مظلة التقسيم السياسي لليمين واليسار الاستعماري. وفي تاريخ الاستعمار الفرنسي، فإن التقسيم يتخذ شكل: الكتلة السياسية في باريس الأكثر براغماتية (تُقرأ: الأكثر خبثاً)، والكتلة السياسية الأكثر راديكالية للمستوطنين في الجزائر المحتلة، أو ما يسمى حينها “الجزائر الفرنسية”، كحركة “الأقدام السوداء” المكونة من المستوطنين الذين وُلدوا في الجزائر المحتلة.
تنعكس هذه البنية على النموذج الصهيوني بشكل أعقد، ولكن للتبسيط، فإن الكتلة السياسية للمستوطنين في الضفة الغربية واليمين الديني الصهيوني كحركة “فتيان التلال” تمثّل المستوطنين الأوروبيين في الجزائر، بينما تمثل “تل أبيب” والنخبة الليبرالية فيها، وصوت الكتلة السياسية الصهيونية في الولايات المتحدة نظير العقلانية النسبية لحكم باريس.
المسألة هنا أن هذا التقسيم، اليميني واليساري، لا يجعل الطرفين، من ناحية المبدأ، مختلفين، فهم ليسوا مختلفين، لكنهم على خلاف. ففي الجزائر، يتفق المركز الفرنسي والمستوطنون على مقولة أن “البحر الأبيض المتوسط يشق فرنسا مثلما يشق نهر السين مدينة باريس”، أي إن الأرض الجزائرية جزء لا يتجزأ من الأرض الفرنسية. وكذلك لا يختلفان في نفي الوجود التاريخي للشعب الجزائري، وهي نقطة أساسية لتبرير أصل المشروع الاستيطاني، مهما اختلفوا تحت سقفه.
أظهر المخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو ذلك ببراعة في فيلم “معركة الجزائر”، في مشهد سؤال ونقد الصحافة اليسارية للكولونيل فيليب الذي قدم لقمع الثورة بدموية، متخذًا سياسة تعذيب المقاومين حتى الموت، حيث وقف أمام الصحفيين الذين ذرفوا دموع التماسيح على شهادة العربي بن مهيدي تحت التعذيب، ليقول:
“حان دوري لسؤالكم: هل تقبلون التخلي عن الجزائر الفرنسية والرحيل؟”
فصمت الجميع، يمينًا ويسارًا، ليبراليين واشتراكيين.
ذات الأمر صهيونيًا؛ فمسألة الضفة الغربية وطريقة احتلالها والحفاظ على ديمومة الكيان مسائل تنفي الاختلاف، ولكنها أيضًا أبرز دوافع الخلاف داخل المعسكر الاستعماري. كان اللعب على هذا الخلاف أحد مفاتيح النصر الجزائري، وهو ما تثابر المقاومة الفلسطينية استغلاله ببراعة.
في الثلاثينيات، حدث خلاف شديد بين المستعمرين في باريس والمستوطنين في الجزائر، ففي حين كان الإنجليز يقتلون الشيخ القسّام ومن ثم يقمعون الثورة الكبرى في فلسطين، كانت الاحتجاجات الجزائرية في أوجها، وإن بمطالب متدنية قائمة على المساواة في الحقوق السياسية مع المستوطنين.
ليأتي ما عُرف بـ”مشروع بلوم-فيوليت”، وهو مشروع يرأسه رئيس حكومة الجبهة الشعبية اليسارية، والذي يقضي بإعطاء نخبة من الجزائريين، قرابة العشرين ألفًا، حق التصويت. بتعبير آخر، هو صنع نخبة ذات امتياز على شعبها، متعاونة مع المستعمر، إلا أن المستوطنين في الجزائر أفشلوا المشروع، رفضًا لأي شكل من أشكال المساواة مع أي من الجزائريين.
يصف الدكتور الزبيري هذا الإفشال بأنه “من حسن حظ الجزائريين”، فقد كان مشروع اليسار وبلوم “مخططًا جهنميًا يهدف إلى حرمان الشعب الجزائري من حقوقه السياسية، وبما يمنع الحركة الوطنية من التطور”، بينما أدى إفشال المشروع إلى فضح مشاريع حكومة اليسار؛ أنها لا تسيطر على الوضع وكلامها مجرد شعارات للاستهلاك، ليعود مشروع الانفصال النهائي عن فرنسا محورًا أساسيًا للحركة الوطنية الجزائرية، وبشكل تحوّل ليكون خيارًا شعبيًا واسعًا، وصلت أصداؤه إلى باريس.
عليه، يسارع شارل ديغول لإلقاء خطاب في قسنطينة في ديسمبر من عام 1943، معلنًا أولًا عن رفع نسبة المسلمين في المجالس المحلية، وثانيًا منح الجنسية إلى 40 ألف جزائري، في محاولة لامتصاص الغضب ودمج الجزائر وابتلاعها كليًا عبر أبنائها. في حقيقة الأمر، كان ديغول يقول للجزائريين: اقبلوا بهذا المشروع، والأربعين ألف جنسية فرنسية، أو سيكون المصير أربعين ألف جثة جزائري، وهذا ما حصل. فقد فات الأوان على مشروع ديغول مع تحوّل الحركة الوطنية الجزائرية، رغم اختلافاتها، إلى سيل جارف لم توقفه سوى مذابح مايو 1945 وارتكاب الفرنسيين للإبادة عبر قتل 45 ألف جزائري في غضون أسبوع.
كانت هذه المذبحة هي الفيصل بين مختلف التيارات الجزائرية، فأيضًا وكما في كل المشاريع الاستعمارية، انقسم الجزائريون سياسيًا بين خط آمن بالكفاح المسلح والعنف الثوري، وخط الخيار السلمي الهادف للاندماج مع فرنسا، بقيادة المتذبذب فرحات عباس، وما يسمى تيار “العباسيين”، وهو الذي وسم عمليات الثورة بالإرهاب في سنتها الأولى. بينما كانت حصة الأسد للتواطؤ مع الاحتلال من نصيب مصالي الحاج وما يسمى بحركة الانتصار للحريات، وهي النموذج الجزائري لتيار ياسر عرفات وأوسلو ومحمود عباس والسلطة اليوم.
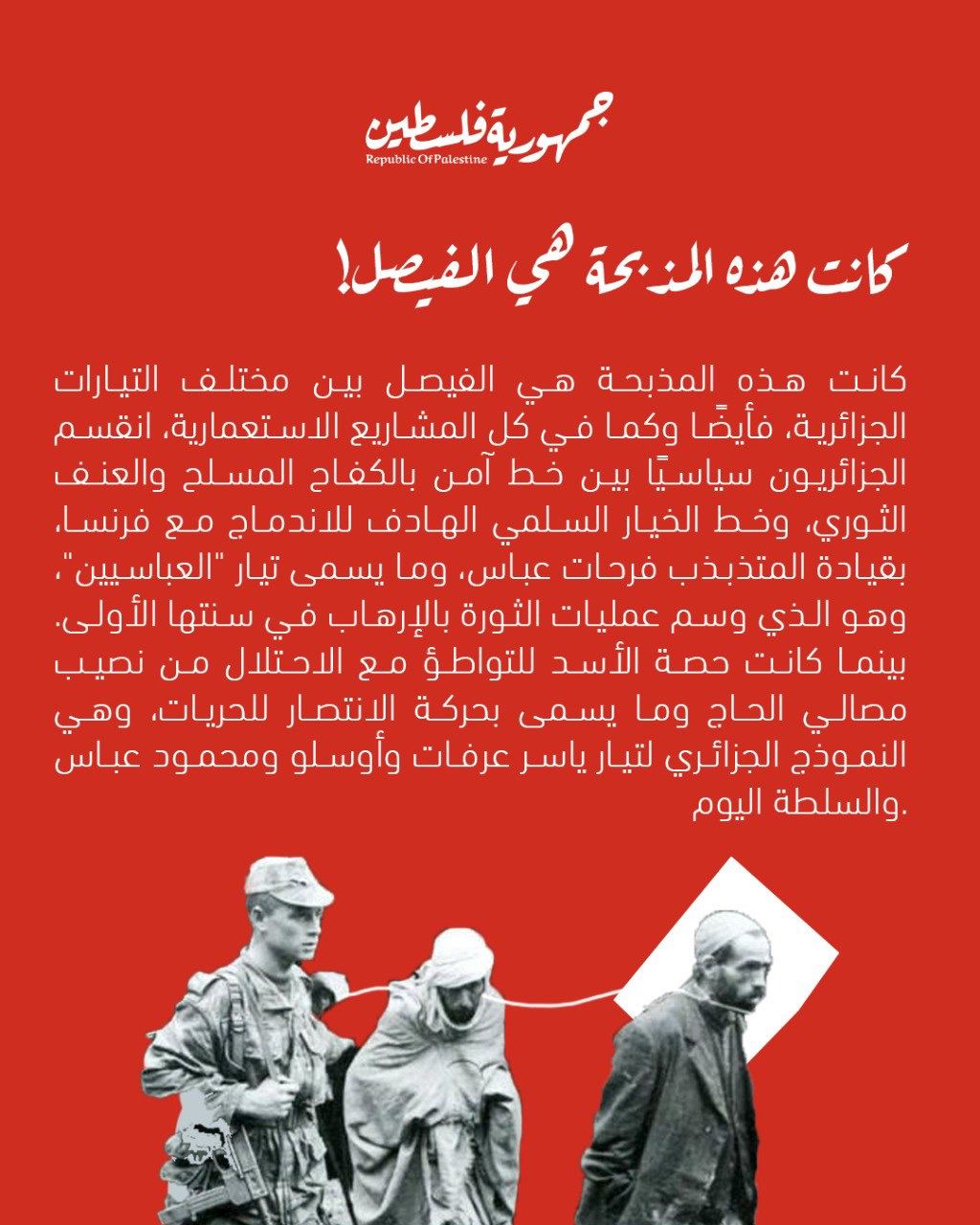
كانت هذه التيارات المساومة والمتواطئة مع المستعمر بوابة محاولة جديدة بقيادة ديغول إلى إعادة ترتيب التشكيل السياسي للجزائر الفرنسية، عبر دمج هذه النخبة وإعطائها امتيازات ووجودًا في المجالس المحلية بوزن أن أصوات تسعة جزائريين تساوي صوت مستوطن فرنسي واحد. هذه الخلفية التاريخية هي مشترك جزائري وفلسطيني، والممهدة لانفجارين: في بيان نوفمبر 1954 وبيان “طوفان الأقصى” 2023.
وكل أزمة دخلت فيها السلطة الفلسطينية ومشروع أوسلو، كانت قد واجهت حركة انتصار الحريات ومشروع المصاليين.
ومن جهة أخرى، كان الخلاف بين شكل “فرنسا الجزائرية” بين المستوطنين والمستعمرين في باريس، قد وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، كما الصراع على شكل الدولة الصهيونية اليوم، بين اليمين واليسار.
لا تتوقف اللحظة الجزائرية فلسطينيًا عند الظروف التي أدت إلى حرب التحرير، بل في ظروف الحرب ذاتها.
عربيًا وعالميًا، كانت هزيمة فرنسا في معركة “ديان بيان فو” بفيتنام مايو 1954 وأزمة الهند الصينية، قد أدخلت الإمدادات العسكرية الفرنسية في أزمة، كما أثبتت أن هزيمة الجيوش الاستعمارية ممكنة. قبلها شكّلت ثورة 23 يوليو في مصر، بقيادة جمال عبد الناصر، ظهيرًا للحركة الوطنية الجزائرية تمويليًا وإعلاميًا وعسكريًا. فقد شكلت إمدادات السلاح للجزائر من كل من تونس والمغرب أزمة لفرنسا، فتبنت ما سمي “خط موريس” عام 1957، وهو عبارة عن جدارين وأسلاك على طول الحدود التونسية والمغربية لمنع تدفق المقاتلين والسلاح. وهنا تحديداً منطق وجوب استثمار البيئة الإقليمية للوضع الجيوسياسي للجمهورية الاسلامية في إيران والقوى العربية المختلفة الداعمة للمقاومة الفلسطينية.
مثلت سنين الثورة الجزائرية مزيجًا بين التضحيات الكبرى والبطولات العسكرية الكبرى والمكاسب الكبرى، فالعمل العسكري أدخل الفرنسيين في حالة جنون، وحملات اعتقال وتعذيب غير مسبوقة، أدخلت الجزائريين في مرحلة مصيرية من الصمود، وأنهت أي مجال من التسويات والمناورات الاستعمارية. كما أنها أدخلت الجيش الفرنسي والحكومة الفرنسية وسلطة المستوطنين وباقي الأحزاب في أزمة اتهام بعضهم البعض حول تحمل مسؤولية الإخفاقات. في الوقت نفسه، بدأ سيل الاعتراف الدولي بشرعية الحكومة الجزائرية المستقلة.
اليوم، وفي العام الثاني من بعد “طوفان الأقصى”، منذ البدء الفعلي للثورة الفلسطينية، تعيش فلسطين وضعًا مصيريًا، شرطها الصمود والاستمرار في المقاومة، أسوة بسنين الثورة الجزائرية. فصهيونيًا، تعيش المستعمرة أزمة داخلية بين أطرافها وإن كانت صوتها لا يعلو حالياً على صوت المعركة. ومن جهة أخرى، والداعم الإمبريالي في الولايات المتحدة وضعاً وتحولات غير مسبوقة بين ذهنية ممارسة الامبراطورية وما تقتضيه من حروب في مقابل الأصوات الصاعدة التي تنادي بتقديم المصالح الوطنية المحلية.
بدون شك، إن فلسطين تعيش لحظة جزائرية، ولكن ذلك لا يقتضي بالضرورة أن يكون المصير جزائريًا. فالمسألة تستدعي العمل، ولم تنجح الثورة الجزائرية وهي حبيسة الأرياف وجبال الأوراس، بل حين وصولها المدن. وفي حين قال الشهيد العربي بنمهيدي: “أن علينا رمي الثورة في الشارع ليتلقفها الشعب”، وإن تأخر ذلك في القدس والضفة، فإن لا خيار لنا سوى نقل الثورة هناك. وهنا تعطينا التجربة التاريخية قدرة تنبؤية، بأن الانتفاضات الفلسطينية لم تأت إلا بعد شعور بانسداد الأفق وهو انسداد ستحرص “إسرائيل” على صنعه بنفسها، بما يوّلد ظرفاً للانتفاضة غير قائم اليوم، مع صخب الإقليم. أما خيار أن تنتصر فلسطين وهناك كتلة جغرافية وبشرية من البلاد وبل من الوطن العربي كله، على كل فرد منا، معفية نسبيًا من التضحية تنتظر الخلاص من السماء، فالجزائر تخبرنا العكس: لم تكن أعوام الثورة بعد بيان نوفمبر في أبرز عناوينها سوى إنهاء الركون والإقصاء والحرب على المتعاونين مع المستعمر، وعلى هذه أن تكون معالم المرحلة المقبلة.