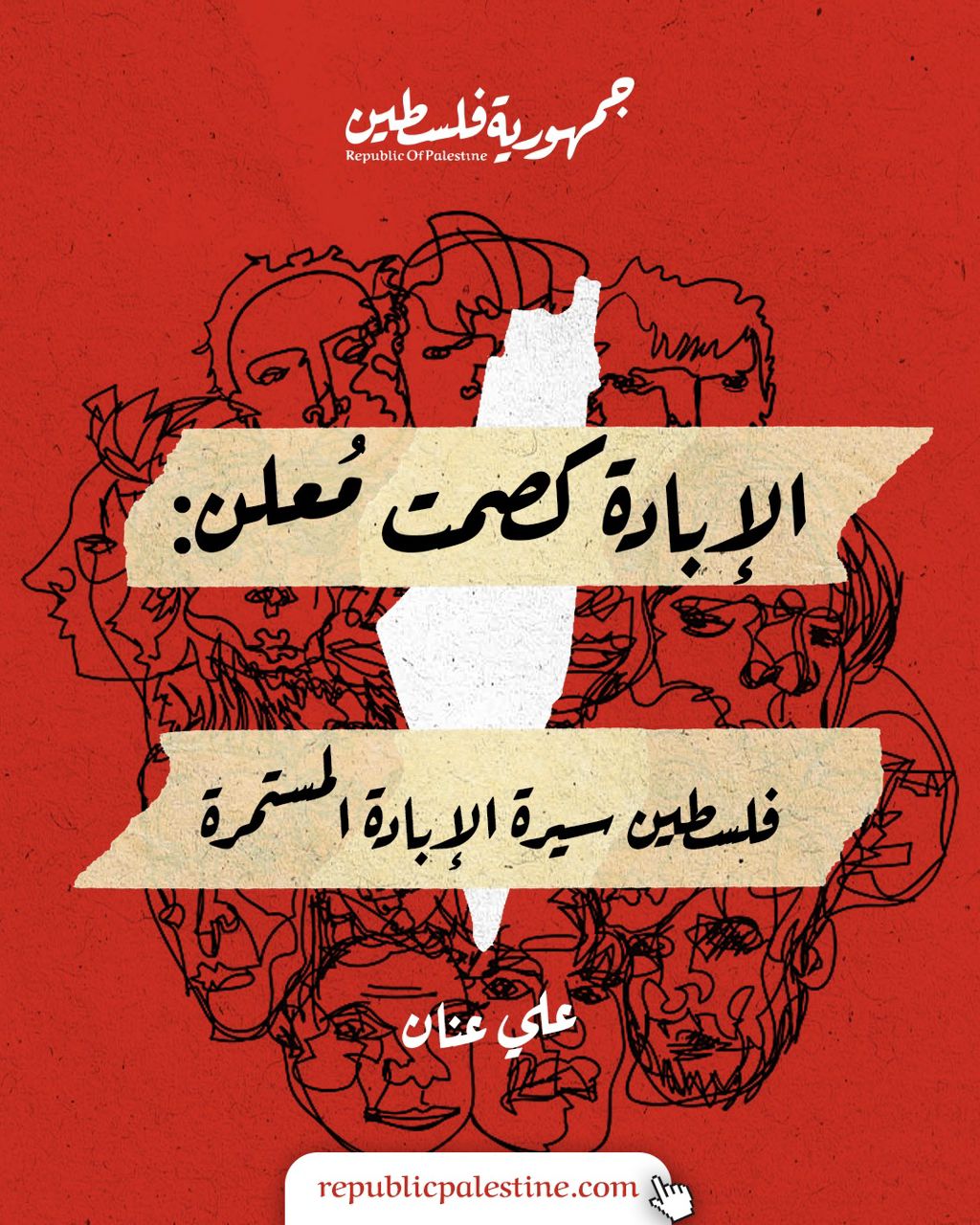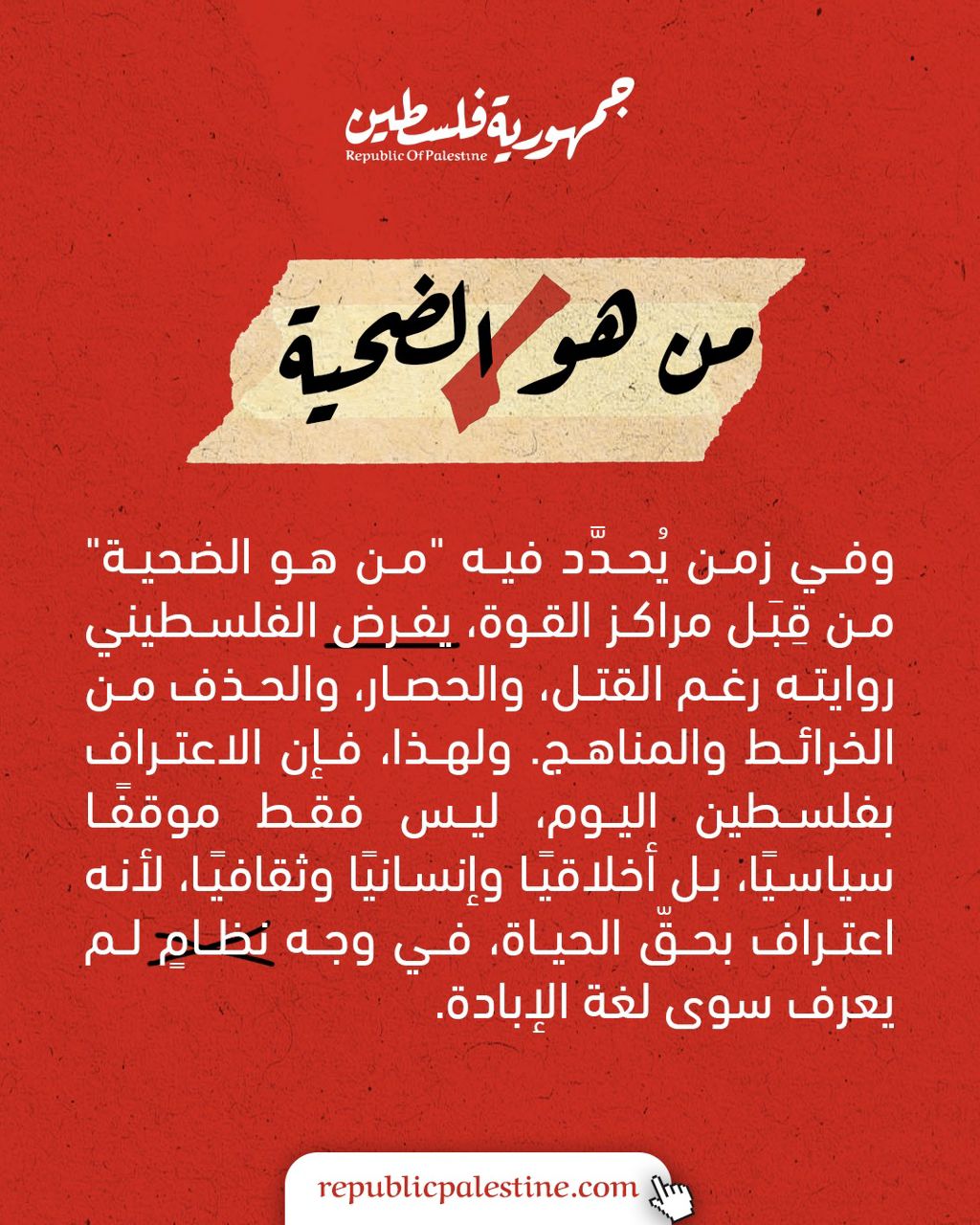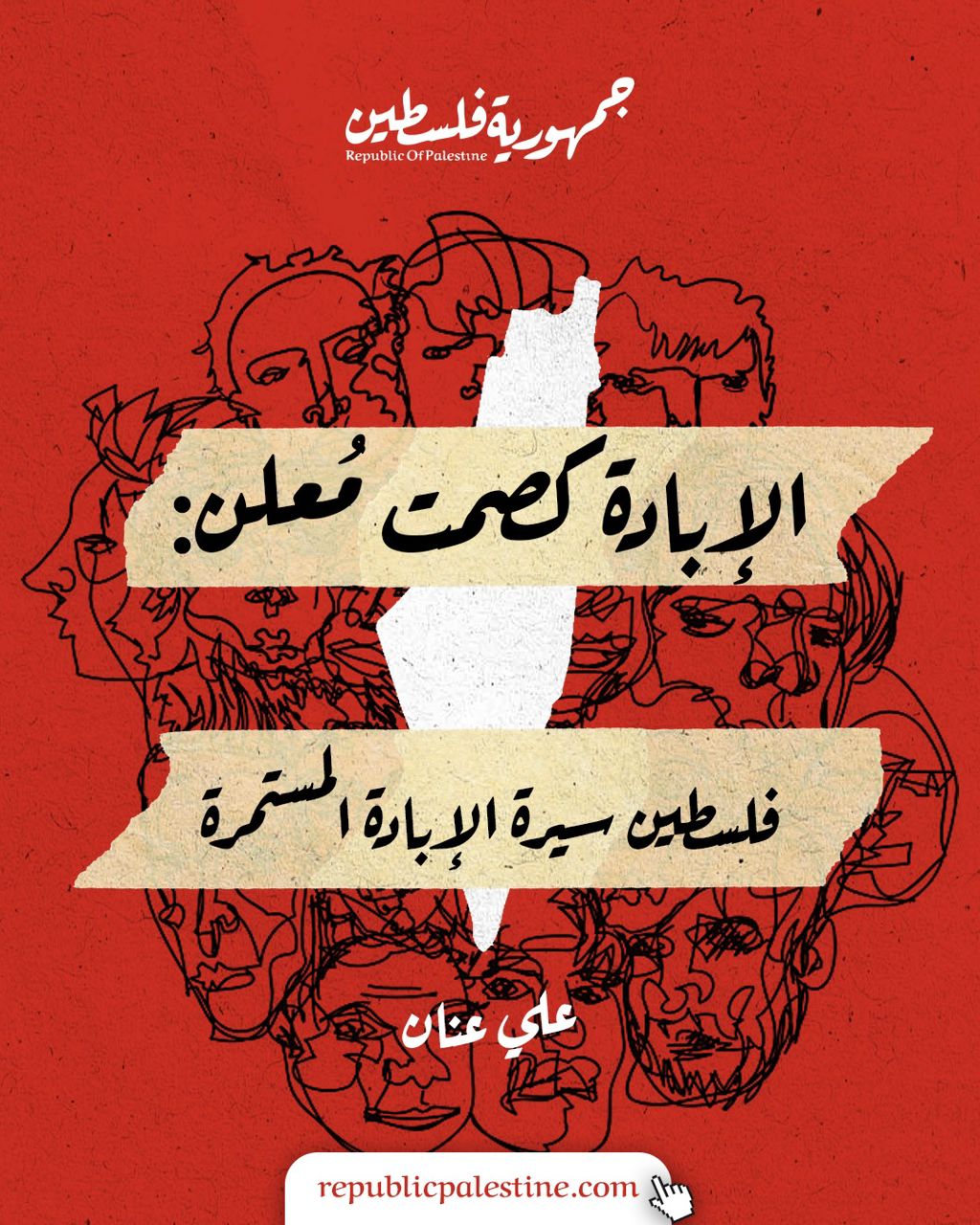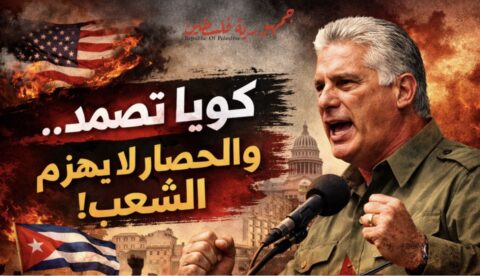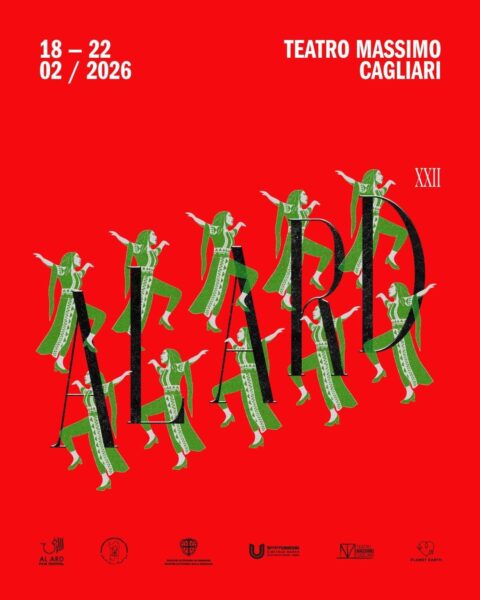بقلم: علي عنان
في كل مرحلة من مراحل التاريخ الإنساني، تتكرّر جريمة تُعيد طرح سؤال الوجود والعدالة والأخلاق إن وجدت. إنها ليست مجرد قتلٍ جماعي، ولا تقتصر على مشاهد العنف الوحشي أو المجازر المصورة، بل تتجاوز ذلك لتلامس عمق البنية الثقافية والرمزية للشعوب. إنها “الإبادة” الجريمة الكبرى التي لا تسعى فقط إلى قتل الإنسان، بل إلى طمس ذاكرته، وإلغاء حضوره، ومحو كل ما يربطه بالمكان والتاريخ.
تزداد محاولات الإعلام العربي والغربي اليوم على تكرار كلمة إبادة على مسامعنا كمشاهدين، يُغرقنا بصور القتل والموت ويكرر كلمة إبادة الاف المرات٫ يحاول أن يقنعنا بأنه إذا توقفت الة الحرب الصهيونية اليوم عن القتل ستتوقف الإبادة، لا اعلم هل حقًا هذا الاعلام لصالحنا ام انه يختزل قضيتنا؟ ويحاول جاهدًا ان يقوم بتمييع المصطلحات وجعلها كلمات سهلة ومستساغة ويمكن للإنسان الجالس امام شاشته ان يسمعها وهو يأكل وجبة غذاء دسمة.
نحاول ان نقترب من مفهوم “الإبادة” بزاوية مختلفة، لا تقتصر على التعريفات القانونية أو النماذج الكلاسيكية، بل تحاول أن تفكك هذا المفهوم ضمن أبعاده الأوسع: الثقافية، الرمزية، الاقتصادية، والوجودية. سنتتبع الجريمة في تمظهراتها المتعددة، من الماضي إلى الحاضر، وسنقف عند الحالة الفلسطينية باعتبارها نموذجًا صارخًا لإبادةٍ مستمرة – لا تنفجر دفعة واحدة، بل تتسلل ببطء، تحت غطاء “الصراع” حينًا، و”الاحتلال” حينًا آخر.
لنعيد لبال القارئ مسيرة شعب تمارس عليه الإبادة، الإبادة بكل اشكالها منذ مئة عام.
الإبادة – المفهوم القانوني والجذور التاريخية
عندما نسمع كلمة “إبادة”، يتبادر إلى الذهن فورًا مشاهد القتل الجماعي، المقابر الجماعية، أو عمليات التطهير العرقي الصادمة التي وثّقها الإعلام أو لاحقتها المحاكم الدولية. لكن الإبادة، كمفهوم قانوني وتاريخي، أعمق وأشمل بكثير من تلك الصور الظاهرة، وتاريخها أطول من الحداثة القانونية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية.
الجذور الأولى لفكرة الإبادة
رغم أن مصطلح الإبادة (Genocide) لم يُصَغ إلا في أربعينيات القرن العشرين، إلا أن ممارساتها تعود إلى بدايات الحضارات والإمبراطوريات. الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية مارست أشكالًا متعددة من الإبادة بحق السكان الأصليين في الأميركيتين وأفريقيا وآسيا. على سبيل المثال، في القرن السادس عشر، تسببت حملات الاستعمار الإسباني والبرتغالي في إبادة ملايين السكان الأصليين في أميركا الجنوبية والوسطى، ليس فقط عبر القتل، بل أيضًا من خلال نشر الأمراض، وتدمير البنى المجتمعية والثقافية، وفرض الدين واللغة بالقوة.
كذلك، ارتكبت الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن العشرين مجازر بحق الأرمن والآشوريين، يُعترف بها الآن على نطاق واسع كواحدة من أولى الإبادات المنظمة في العصر الحديث.
صياغة المفهوم القانوني: من المجازر إلى النصوص
صُكّ مصطلح “Genocide” عام 1944 على يد القانوني البولندي اليهودي رافائيل ليمكين، أثناء فراره من أوروبا النازية. جمع الكلمة من كلمتين: “genos” (يونانية وتعني العِرق أو الجماعة) و”cide” (لاتينية وتعني القتل). اقترح ليمكين هذا المصطلح لوصف الجرائم التي تتجاوز حدود القتل الفردي لتستهدف جماعة بأكملها لمجرد انتمائها العرقي أو الديني أو القومي.
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تم تبنّي المصطلح رسميًا في القانون الدولي، خاصة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948. تُعرّف الاتفاقية الإبادة بأنها:
“أية أفعال تُرتكب بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية، بصفتها تلك.”
وتشمل الأفعال المحددة في الاتفاقية ما يلي:
- قتل أعضاء الجماعة.
- التسبب بأذى جسدي أو نفسي جسيم.
- فرض ظروف حياة يُقصد بها التدمير التدريجي.
- فرض إجراءات لمنع الإنجاب.
- نقل الأطفال قسرًا إلى جماعة أخرى.
رغم أهمية هذا التعريف القانوني، إلا أنه لم يخلُ من الإشكاليات. فقد ركّز بشكل كبير على الأفعال الجسدية والمباشرة، وأهمل الأبعاد الرمزية والثقافية. بمعنى آخر، لا يشمل التعريف الرسمي ما يُسمّى بالإبادة الثقافية أو الرمزية، والتي تتمثّل في محو اللغة، تغيير المناهج التعليمية، تدمير الآثار والموروثات، طمس أسماء الأماكن، وغيرها من السياسات التي تستهدف “ذاكرة” الجماعة المستهدفة. هذا القصور فتح المجال للكثير من الدول لارتكاب جرائم إبادة ببطء، وبشكل مؤسساتي، دون أن تقع تحت طائلة القانون الدولي، لأنها ببساطة لا تُطلق النار، بل تحاصر، تُفقِر، تُهمّش، تُعيد كتابة التاريخ.
إشكالية النية
أحد التحديات الكبرى في إثبات الإبادة قانونيًا هو إثبات “النية” – أي أن الجاني كان يهدف فعلًا إلى تدمير الجماعة. وهذا صعب التحقق خاصة في حالات الإبادة البطيئة أو المُموّهة. ولهذا، كثير من الجرائم التي تتوفر فيها أركان الإبادة لا تُحاسب على هذا الأساس، بل تُصنّف كـ “جرائم ضد الإنسانية” أو “جرائم حرب”، وهو ما يفرغ المفهوم من جوهره ويمنح المجرمين غطاء قانونيًا ودبلوماسيًا.
من القانون إلى الواقع
رغم مرور أكثر من سبعة عقود على صدور اتفاقية منع الإبادة، إلا أن الواقع يشهد على عجز المجتمع الدولي عن منعها أو معاقبة مرتكبيها. من البوسنة إلى رواندا، ومن ميانمار إلى فلسطين، تستمر الجرائم، وتتبدّل أدواتها، وتبقى الأسئلة بلا إجابة: من يحق له تسمية الجريمة؟ ومن يملك سلطة الاعتراف؟
فلسطين، كما سنرى في المحاور التالية، تُقدّم حالة نموذجية لإبادة مستمرة لم تُسمَّ باسمها رغم وضوح أدواتها. وهذا ما يجعلنا نُصرّ على أهمية توسيع فهمنا لهذا المفهوم، والذهاب به أبعد من النصوص القانونية الجامدة.
الإبادة كأداة ثقافية – من محو اللغة إلى إلغاء الذاكرة
حين نتحدث عن الإبادة، غالبًا ما يتبادر إلى الذهن القتل، الإعدام الجماعي، أو المجازر المسلحة. لكن ماذا لو أن الهدف لم يكن الجسد فقط، بل ما يُمثّله هذا الجسد؟ ماذا لو لم تكن الضحية فقط شخصًا يُقتل، بل ثقافة تُنتزع من الوعي، ولغة تُقطع من لسان الأجيال، وذاكرة تُمحى من الأرض؟
في هذا المحور، نُوسّع دائرة النظر نحو الإبادة الثقافية، باعتبارها الأداة الأخطر، والأقل ظهورًا، والأكثر فاعلية في تنفيذ مشروع الإبادة الطويلة الأمد. لأن الثقافة، ببساطة، هي ما يجعل الجماعة بشرًا، ويمنحها معنى، ويربطها بمكانها وزمانها.
اللغة: حين تُغتال الذاكرة من اللسان
اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي الوعاء الذي يُحمّل القيم، الحكايات، الأمثال، الأغاني، والمفردات المرتبطة بالمكان. حين تُمنَع جماعة ما من التحدث بلغتها، أو حين تُفرض عليها لغة أخرى باعتبارها “أرقى” أو “أقوى”، فإن ذلك ليس قرارًا تربويًا أو تعليميًا، بل فعل إبادة رمزية.
في الولايات المتحدة وكندا، خضع أطفال السكان الأصليين لمدارس داخلية أجبرتهم على نسيان لغاتهم الأصلية، وتمت معاقبتهم على استخدام لغاتهم الأم، مما أدى إلى اختفاء العشرات من اللغات خلال قرن واحد فقط. هذه الممارسات لا تقل وحشية عن الرصاص، لأنها تقتل العلاقة بين الإنسان وتاريخه.
تغيير المناهج وتزوير التاريخ
من أبرز أدوات الإبادة الثقافية، إعادة كتابة التاريخ. فحين تُقدَّم الجماعة المستهدَفة كغريبة، بدائية، أو حتى عدوة، يتم نزع الشرعية عن وجودها ذاته. والمناهج المدرسية تُستخدم كأداة استراتيجية في هذا السياق.
في كثير من الدول التي تمارس الاضطهاد أو الاستعمار، يتم حذف التاريخ الحقيقي للمكان، ويتم تصوير السكان الأصليين كـ “بدايات منتهية” أو “أقليات غير فاعلة”، بينما يُمجَّد الغازي أو المستوطن.
مثلاً، في السياق الفلسطيني، يتم تغييب وجود القرى الفلسطينية المدمّرة في المناهج “الإسرائيلية”، وتُقدَّم الأرض وكأنها بلا شعب، أو أن السكان الأصليين قد “غادروا طوعًا”، في تزييف فجّ للنكبة. هذا التزييف لا يُمحى إلا بالمعرفة، والتوثيق، والاستعادة الثقافية المستمرة من طرف الفلسطينيين أنفسهم.
تدمير الرموز والموروثات: عندما يُهدم الوجدان
الموروث المعماري، الرمزي، والفني هو جزء من الذاكرة الجمعية. تدمير المساجد، الكنائس، المقابر، البيوت القديمة، وحتى الأشجار، ليس مجرد خسارة مادية، بل ضربة للارتباط العاطفي والنفسي بين الناس وأرضهم.
في حالة فلسطين، عمليات “التهويد” التي تمارس في القدس أو الجليل أو النقب لا تقتصر على تغيير أسماء الشوارع، بل تمتد إلى طمس الهوية العربية للمكان: تغيير أسماء القرى، طمس المعالم، تحويل البيوت التاريخية إلى مقاهٍ ومتاحف تحمل أسماءً أجنبية.
الأمر ذاته حدث في حالات أخرى: في سراييفو بعد الحرب، سعت القوى المسيطرة إلى إعادة تشكيل المدينة بملامح إثنية محددة، وفي الأندلس، أُخفيت المعالم الإسلامية بعد سقوطها، لتُعاد صياغتها في إطار أوربي خالص.
سرقة الفولكلور: الاستيلاء الناعم على الهوية
جانبٌ آخر من الإبادة الثقافية هو الاستيلاء على الفولكلور، وتقديمه باسم المستعمر أو المستوطن. في فلسطين، نرى هذا بوضوح في محاولات الاحتلال نسب الأكلات الشعبية (كالحمص والفلافل والمجدّرة) إلى “التراث الإسرائيلي”، أو تقديم الأزياء والموسيقى الشعبية الفلسطينية على أنها “إرث يهودي قديم”.
هذه السرقة الرمزية ليست هامشية، بل جزء من محاولة بناء رواية موازية تلغي الوجود الأصلي، وتقدّم الكيان المستعمِر على أنه “المالك الشرعي الوحيد” للثقافة والمكان.
الرقابة ومنع التعبير
الإبادة الثقافية تُمارَس أيضًا عبر القوانين والسياسات التي تمنع الفنانين والكتّاب والموسيقيين من التعبير عن روايتهم. في أماكن كثيرة، يُلاحق المثقفون والناشطون قانونيًا لأنهم يُذكّرون الناس بتاريخهم، أو يُحيون لغةً أو طقسًا شعبيًا.
في فلسطين، تُمنَع بعض الكتب من الدخول إلى غزة أو الضفة الغربية، وتُلاحَق فرق فنية إذا قدّمت أغنيات وطنية، ويُحاصر الإعلام المستقل الذي يوثّق الانتهاكات أو يفضح التزوير.
حين تتحوّل الإبادة الثقافية إلى مقدّمة للإبادة المادية
التاريخ يُظهر بوضوح أن الإبادة الثقافية غالبًا ما تسبق أو ترافق الإبادة المادية. فحين تُجرَّد الجماعة من إنسانيتها الرمزية، يصبح قتلها أسهل، ويتم “تبرير” العنف بحقها باعتباره ضرورة سياسية أو أمنية.
تجريد شعب من تاريخه، لغته، أغانيه، حكاياته، وأمكنته، هو فعل محو يُعبّد الطريق للفعل الدموي لاحقًا. لهذا، فإن الدفاع عن الثقافة واللغة والرواية ليس ترفًا فكريًا، بل هو شكل من أشكال البقاء والمقاومة.
الإبادة في فلسطين – مشروع استعماري متجدد: من المجازر إلى التهجير البنيوي
حين نقترب من فلسطين، لا نواجه مجرد احتلال أو “صراع” تقليدي كما تروج كثير من وسائل الإعلام والمؤسسات السياسية، بل نحن أمام مشروع إبادة طويل النفس، متعدد الأدوات، يستهدف الإنسان الفلسطيني في كيانه الكامل: جسده، أرضه، لغته، ذاكرته، مستقبله، حتى روايته.
الإبادة هنا لا تتم دفعة واحدة، ولا تأتي على هيئة معسكرات اعتقال ضخمة أو مشانق جماعية، بل تتغلغل في كل زاوية من زوايا الحياة اليومية، وتحمل ملامح الاستعمار الاستيطاني، الذي لا يكتفي بالسيطرة على الأرض، بل يسعى إلى محو الشعب كليًا وإحلال جماعة أخرى مكانه.
هذا المحور يُفكك الإبادة في فلسطين ليس كمجرد أحداث متفرقة، بل كمخطط استراتيجي منهجي، يمتد من نكبة 1948 حتى حرب الإبادة الشاملة على غزة، ويستمر في أشكال أكثر خفاءً في القدس والضفة، والنقب والجليل والشتات.
النكبة: بداية الإبادة الحديثة
نكبة 1948 ليست فقط لحظة تأسيس “إسرائيل”، بل لحظة التدمير المنهجي للشعب الفلسطيني ككيان وطني متكامل. في غضون شهور، طُرد أكثر من 750,000 فلسطيني من قراهم ومدنهم، ودُمرت أكثر من 500 قرية، عبر مجازر ممنهجة موثقة (دير ياسين، الطنطورة، صفصاف، وغيرها).
هذه الإبادة لم تكن عشوائية، بل جاءت ضمن خطة صهيونية واضحة: “خطة دال” (Plan Dalet)، التي صاغتها منظمة الهاجاناه، والتي هدفت إلى إفراغ أكبر قدر ممكن من الأرض من سكانها العرب قبل إعلان الدولة.
تم تدمير منازل الفلسطينيين بالديناميت، جرى تسميم الآبار، منع العودة بالقوة، ومسح أسماء القرى من الخرائط واستبدالها بأسماء عبرية. ما حدث ليس مجرد تهجير، بل طمس متعمد للوجود، أي الإبادة الثقافية والمكانية.
الإبادة في المخيم: حين يُقتل اللاجئ مرتين
معظم اللاجئين الذين خرجوا في النكبة انتهى بهم المطاف في مخيمات مؤقتة، تحوّلت إلى أماكن دائمة، دون جنسية أو حقوق مدنية كاملة. لكن المخيم لم يكن مجرد مأساة إنسانية، بل مسرحًا مستمرًا لإعادة إنتاج الإبادة بطرق غير مباشرة.
في صبرا وشاتيلا (1982)، نفّذت ميليشيات الكتائب اللبنانية، بإشراف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة استمرت لأيام. أكثر من 3,000 مدني فلسطيني – من النساء والأطفال والرجال – قُتلوا دون أن يتدخل أحد.
النكبة لا تزال مستمرة في المخيمات، من تل الزعتر إلى جنين، ومن نهر البارد إلى غزة، حيث يُحاصَر الفلسطيني لا بالجدران فقط، بل بالحرمان من الاعتراف، ومن المستقبل.
الإبادة في القدس: هدم الحي والحيز والهوية
في القدس، تأخذ الإبادة شكل “التفتيت الهادئ”. يتم تجريد الفلسطينيين من إقاماتهم بشكل منهجي، وتُهدم أحياؤهم بذريعة “البناء غير المرخّص”، في حين يُمنع عليهم التوسع أو الترميم.
من حي الشيخ جراح إلى سلوان، يتم تحويل الحياة اليومية إلى معركة بقاء قانونية ونفسية. تُحاصر العائلات بأوامر الإخلاء، وتُعرض عليها “صفقات” تعني الاعتراف بالمستعمر كمُلك للعقار. وفي كل خطوة، تُستخدم المحاكم الإسرائيلية كأداة لإبقاء الجرائم في غلاف “الشرعية القانونية”.
كل ذلك، إلى جانب محاولات تهويد الأسماء، وإحاطة المسجد الأقصى بالأحياء الاستيطانية، ونزع أي مظهر للسيادة الفلسطينية في المدينة، يصب في هدف واحد: خلق مدينة بلا سكانها الأصليين، عبر إبادة مجتمعية ناعمة.
غزة: المختبر المفتوح للإبادة الجماعية
قطاع غزة، منذ 2007 وحتى 2024، تحوّل إلى أكبر مختبر للإبادة الجماعية في العصر الحديث. الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023 – والتي وُصفت من قبل خبراء حقوق الإنسان بـ “الإبادة المعلنة” – كشفت النقاب عن أقصى درجات التوحّش المنهجي:
- قُتل أكثر من 35,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
- دُمّر أكثر من 70% من البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمساجد.
- حُرم السكان من المياه، والكهرباء، والدواء، والغذاء.
- جرت عمليات استهداف للأطقم الطبية، الإعلاميين، والأكاديميين.
- استخدمت “إسرائيل” مصطلحات مثل “حيوانات بشرية”، و”دمروا غزة تمامًا”، في تصريحات علنية لمسؤولين سياسيين وعسكريين.
خبراء من الأمم المتحدة، من ضمنهم فرانسيس بويل، ومقرّرون سابقون مثل ريتشارد فولك ومايكل لينك، أكدوا أن ما يحدث ينطبق تمامًا على تعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية 1948.
الإبادة الإدارية والقانونية: عندما تصبح البيروقراطية أداة قتل
من أشكال الإبادة الأقل وضوحًا وأكثر خنقًا، هي تلك التي تُمارَس عبر الأنظمة القانونية والإدارية. في الضفة الغربية، يُفرض على الفلسطينيين نظام تصاريح معقد للتحرك داخل أراضيهم، ويُحرمون من حرية التنقل، ويُعاقَبون جماعيًا.
في القدس، يُسحب حق الإقامة من سكانها إذا غادروا المدينة لأكثر من مدة محددة. بينما يمنع الفلسطيني من بناء بيت، أو زراعة أرضه، أو حتى حفر بئر، يُمنح المستوطن الصلاحية الكاملة لفعل ما يشاء.
بهذه الطريقة، تتحول أدوات الدولة – القانون، المحاكم، الشرطة، السجلات المدنية – إلى أدوات إبادة تُمارس تحت غطاء “النظام”، وبتواطؤ مجتمع دولي يدّعي أنه لا يرى.
سياسات التجويع والحصار: الإبادة البطيئة
في غزة تحديدًا، يُستخدم الحصار كوسيلة إبادة منهجية. منذ 2007، يعيش أكثر من مليوني إنسان تحت حصار خانق، يتحكم الاحتلال في عدد السعرات الحرارية المسموح بدخولها يوميًا، كما كشفت وثائق إسرائيلية مسرّبة.
هذه السياسات لا تستهدف فقط خنق الاقتصاد، بل تدمير الحياة بكاملها: حرمان الطلاب من السفر، المرضى من العلاج، المؤسسات من الكهرباء، الصيادين من البحر، والمزارعين من الأرض.
وكل هذه الممارسات، بحسب تقارير منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، تندرج تحت تعريف “الإبادة من خلال التجويع”، وهي جريمة موثقة في القانون الدولي.
عندما تتحول الذاكرة إلى مسرح مواجهة
الفلسطيني اليوم لا يدافع فقط عن جسده، بل عن ذاكرته. كل قرية مدمرة، كل اسم شارع تم تهويده، كل رقصة أو مأكله أو زي شعبي تُنسب للمحتل، هو ساحة مقاومة.
المخيم، الزيتونة، الأغنية، الكوفية، حتى اللهجة، أصبحت أدوات بقاء. فالإبادة التي لا تُطلق فيها النار تُقاوَم بالحكاية، بالأغنية، بالملصق، بالقصيدة، بالصمود في البيت رغم أوامر الإخلاء.
لهذا، فإن مشروع الإبادة في فلسطين ليس فقط جريمة مستمرة، بل جريمة مُستمرة في إنتاج أشكال مقاومة حية، تجعل من الشعب الفلسطيني واحدًا من الشعوب النادرة في التاريخ التي واجهت الإبادة بإرادة الوجود الثقافي والوطني.
الاعتراف بالإبادة – من يملك سلطة التسمية؟ السياسة الدولية والتواطؤ العالمي
إذا كانت الإبادة جريمة بحجم الوجود الإنساني، فإن التواطؤ في إنكارها أو الصمت عنها ليس مجرد خطأ أخلاقي، بل شراكة فعلية في الجريمة. ما يجعل الإبادة أكثر رعبًا في عصرنا ليس فقط أن تُرتكب، بل أن يتم إخفاؤها، تبريرها، أو إعادة تأطيرها ضمن سرديات مضلّلة تخدم مصالح القوى الكبرى. وهنا نواجه سؤالًا محوريًا: من يملك الحق في تسمية الجريمة؟ ومن يملك سلطة الاعتراف؟
هذا المحور يحاول تفكيك بنية الاعتراف بالإبادة، سياسيًا وقانونيًا وثقافيًا، ويكشف عن حجم التواطؤ الدولي في انتقاء “الضحايا الجديرين بالاعتراف” مقابل أولئك الذين يُطلب منهم أن يصمتوا كي لا يُتهموا بـ “التحريض” أو “المبالغة” أو حتى “معاداة السامية”.
الاعتراف بالإبادة ليس مسألة قانونية فقط
من الناحية الشكلية، تبدو الأمور بسيطة: إذا توفّرت أركان الجريمة بحسب اتفاقية 1948 – النية، الفعل، استهداف جماعة محمية – فإن الجريمة تُسمى إبادة، ويجب على الدول الموقعة أن تتحرك لمنعها أو معاقبة مرتكبيها. لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا.
فالاعتراف بالإبادة لا يتم فقط على أساس الأدلة أو الوقائع، بل بناءً على موازين القوى، والمصالح، والتحالفات الجيوسياسية. بمعنى آخر، هناك إبادات يُسمح لها أن تُسمى، لأنها لا تُهدد مصالح الغرب أو لأنها تقع في مناطق “مستقرة سياسياً”، وهناك إبادات تُدفن، لأنها تُرتكب على يد حليف إستراتيجي أو ضمن سردية يُراد حمايتها.
مثال بسيط: حتى عام 2021، كانت الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بالإبادة الأرمنية، رغم كل الأدلة التاريخية، فقط حفاظًا على علاقاتها مع تركيا – عضو حلف الناتو.
إسرائيل والاستثناء الدائم
تُعتبر “إسرائيل” حالة نادرة في التاريخ السياسي الحديث: دولة أُنشئت جزئيًا كتعويض عن جريمة إبادة (الهولوكوست)، لكنها تُمارس مشروع إبادة ممنهج ضد شعب آخر، في تناقض صارخ لا يمكن تفسيره إلا باعتبارها مدعومة بمنظومة دولية تخلق لها “حصانة أخلاقية مسبقة”.
في الإعلام الغربي، يندر استخدام مصطلح “genocide” لوصف ما يحدث في فلسطين، حتى في ذروة حرب غزة، التي وصفها خبراء دوليون بأنها إبادة مكتملة الأركان. في المقابل، يُستخدم المصطلح بسهولة عند الحديث عن أعداء الغرب.
وهكذا، لا تُقاس الجريمة بمعايير القانون، بل بمعايير “الموقع السياسي للجاني والضحية”.
المحكمة الجنائية الدولية: أدوات قانونية في قبضة السياسة
رغم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، إلا أنها – واقعياً – لا تملك سلطة مستقلة حقيقية. كثير من الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة و”إسرائيل”، ليست أطرافًا موقّعة على نظام روما الأساسي، ما يمنحها حماية من المحاكمة.
وحين تُجرى تحقيقات فعلية كما حصل بعد مجزرة غزة، تُمارس ضغوط هائلة على المحكمة، ويُشهر في وجهها سلاح “التمييز” أو “التسييس”. وهذا ما حصل عندما أعلن المدعي العام كريم خان عن نيّته ملاحقة قادة الاحتلال، حيث تم تهديد المحكمة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، كما فعلت إدارة ترامب من قبل حين لاحقت المحكمة لتجرؤها على التحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان وفلسطين.
الإعلام: من يسرد القصة ومن يصيغ المفردات؟
جزء كبير من سلطة تسمية الإبادة يقع اليوم في يد وسائل الإعلام الكبرى، التي تُحدد للناس “كيف يرون” الأحداث. وعبر التحكم بالمفردات، يتم تقديم الجريمة بعبارات مخففة أو مضللة:
- بدل “إبادة”، يُقال “صراع”.
- بدل “تطهير عرقي”، يُقال “إعادة تموضع سكان”.
- بدل “قتل المدنيين”، يُقال “أضرار جانبية”.
- بدل “محو مدينة”، يُقال “عملية أمنية دقيقة”.
في حالة فلسطين، الإعلام الغربي السائد يروّج منذ عقود لرواية الاحتلال، ويُسهم في تجريد الفلسطيني من إنسانيته، ما يفتح المجال لإبادة تُرتكب على مراحل، دون أن تُسجَّل رسميًا كجريمة إبادة.
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: بين العجز والتواطؤ
رغم وجود تقارير موثقة، وآلاف الوثائق التي تثبت وقوع جرائم إبادة في فلسطين، إلا أن الأمم المتحدة نادرًا ما تُسمّي الأشياء بمسمياتها. غالبًا ما تكتفي بـ “القلق”، و”الدعوة إلى ضبط النفس”، دون اتخاذ إجراءات ملموسة.
في غزة، ورغم الحصار والتجويع والمجازر، لم تُفرض حتى الآن عقوبات دولية على الاحتلال، ولم يتم تجميد عضويته في أي هيئة دولية. كل ما نُقل عن الأمم المتحدة هو “أوصاف” مثل “كابوس إنساني”، أو “كارثة غير مسبوقة”، دون أن يُقال: “إبادة”.
وهذا الصمت، أو التجنّب المقصود، جزء من الجريمة.
القانون نفسه جزء من المشكلة؟
في النهاية، لا بد من مساءلة القانون الدولي نفسه. هل الاتفاقيات التي وُضعت بعد الحرب العالمية الثانية فعالة أصلًا؟ وهل تستطيع حماية الشعوب المستضعفة دون أن تخضع لتوازنات القوى؟ وما جدوى وجود مصطلحات مثل “إبادة” إذا لم تُطبّق إلا على الضعفاء؟
ربما ما نحتاجه اليوم ليس فقط تعديل المفاهيم، بل إعادة التفكير فيمن يملك الحق في تسمية الألم. أن نعيد السلطة إلى الضحايا أنفسهم، إلى الشعوب التي تُباد وهي تقاوم، إلى الرواية الشعبية التي لا تخضع للقوانين ولا للقنوات الدبلوماسية.
واجب التسمية: المقاومة تبدأ باللغة
أن نسمي ما يجري في فلسطين بأنه إبادة، هو عمل مقاومة. لأن الصمت مساهمة، واللغة مشاركة، والتواطؤ ليس فقط بالسكوت، بل بإعادة صياغة الجريمة بلغة تُخفيها.
وفي هذا السياق، فإن دور المثقف، الصحفي، الفنان، الناشط، والمؤرخ، هو أن يُسمّي، أن يصرّ على التسمية، لأن ما لا يُسمّى لا يُدان، وما لا يُدان يتكرر.
من الجذر إلى الذاكرة – النضال المستمر ضد الإبادة
ليست قصة الفلسطيني مع الزيتون، أو مع القرى المهدّمة، أو مع الجغرافيا المتعرقلة بكثرة الحواجز، مجرد فصول من التاريخ. هي قصة الإنسان الذي رفض أن يكون ضحيةً صامتةً، وقاوم محاولات محوه ليس فقط بالبقاء، بل بالإبداع، بإعادة تشكيل ذاته، وبخلق سرديته من عمق الجرح.
لقد بيّنا أن الإبادة في فلسطين ليست حدثًا طارئًا، بل مشروعًا استعماريًا متكاملًا. مشروع يبدأ بتهويد الأرض وينتهي بتهويد المعنى. يُقصف البيت، لكن يُلاحَق الحرف أيضًا. تُقتلع الشجرة، لكن يُلاحَق الثوب المطرّز، والقصيدة، واللحن، واللهجة. وهذا ما يجعل النضال الفلسطيني فريدًا: نضالٌ مادي وثقافي، وجودي وسردي، يقف فيه الجسد إلى جانب الكلمة، والرصاصة إلى جانب الحكاية، واللاجئ إلى جانب الفنان.
وفي مقابل مشروع الإبادة، تتشكّل منظومة مقاومة حيّة، تتغيّر أدواتها، لكن تبقى روحها واحدة: الدفاع عن الحياة، عن المعنى، عن التاريخ، عن الإنسان. مقاومة لا تكتفي برفض النفي، بل تطرح وجودها كحقيقة لا تُزاح، تُوثّق، وتُغنّى، وتُوشم في الذاكرة.
فمن حيفا إلى غزة، ومن جنين إلى الشتات، ومن مخيمات لبنان إلى حواري القدس، يعيش الفلسطيني في معركة دائمة مع محوٍ مُمَنهج. لكنه لم يخسر. بل صنع من الهزيمة طريقًا للإصرار، ومن الركام صعودًا جديدًا، ومن الألم وجعًا جمعيًا يُغنّى ويُدرّس ويُرسَم ويُورَّث.
وفي زمن يُحدَّد فيه “من هو الضحية” من قِبَل مراكز القوة، يفرض الفلسطيني روايته رغم القتل، والحصار، والحذف من الخرائط والمناهج. ولهذا، فإن الاعتراف بفلسطين اليوم، ليس فقط موقفًا سياسيًا، بل أخلاقيًا وإنسانيًا وثقافيًا، لأنه اعتراف بحقّ الحياة، في وجه نظامٍ لم يعرف سوى لغة الإبادة.
ختامًا، فإن بقاء الزيتونة ليس فقط بقاء شجرة، بل بقاء شعبٍ اختار أن يكون ذا جذور، لا ظلًّا. شعبٌ كلما حوصِر أكثر، نما أكثر، وتحوّل من حالة نكبة إلى حالة مقاومة. مقاومة، لا تزول.