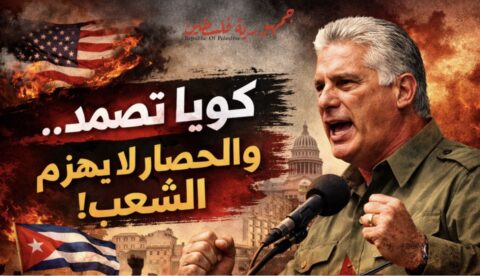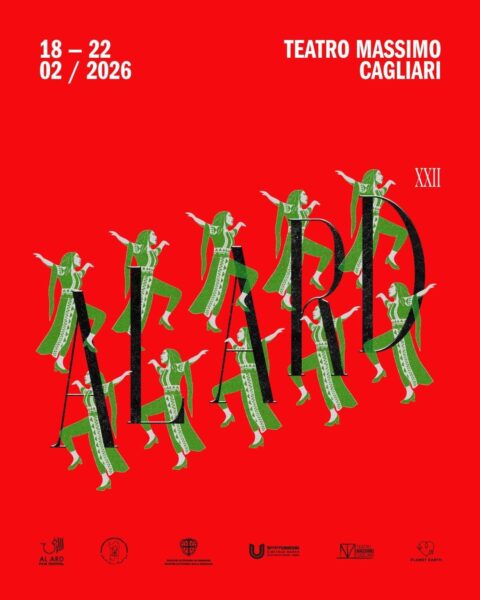هذا المقال تم نشره على موقع جريدة الأخبار اللبنانية بتاريخ 28 تشرين الأول 2025.
بقلم: محمود عبدالحكيم.
* «اللي ما انحبسش آخر سنتين ما انحبسش»
* المواجهة من دون مقاومة مسلّحة أمر غير مسبوق
التقت «الأخبار» الأسير المحرّر نادر ممدوح صالح صدقة، المعروف بـ«نادر السامري»، والذي أُطلق سراحه في الصفقة الأخيرة، وكان – بصفته القيادية ودوره في الأسر واحداً من أبرز أسماء «أسرى المؤبدات» الذين سعت المقاومة مراراً لإدراجهم في صفقات التبادل، في أحد فنادق أطراف القاهرة الكبرى، حيث يقيم مع الأسرى المُبعَدين. وخلال الحوار، تناول التاريخ – الذي يبدو الرجل من دارسيه المخضرمين – والوضع السياسي، بالإضافة إلى المحطة الراهنة التي تشهدها القضية الفلسطينية
وُلد نادر ممدوح صالح صدقة، المعروف بـ«نادر السامري»، في نابلس عام 1977، لأسرة من الطائفة السامرية في فلسطين. درس التاريخ والآثار في جامعة النجاح الوطنية، حيث تفتّح وعيه السياسي، وكان أحد كوادر «جبهة العمل الطالبي التقدّمية»، الذراع الطالبية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، التحق بـ«الجبهة الشعبية» مباشرة، وأهّلته إمكاناته التنظيمية والفكرية خلال سنوات قليلة لتولّي قيادة «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى» – الذراع العسكرية لـ«الجبهة» – في نابلس. طاردته قوات الاحتلال لعامين، اضطُرّ خلالهما إلى التخفّي والتنقّل بانتظام من مكان إلى آخر، فيما استُشهد عددٌ من أقرب رفاقه. وليتمكّن من اعتقاله، نفّذ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مخيم العين بمدينة نابلس في آب 2004، انتهت بأسره، ليُحكَم عليه لاحقاً بالسجن ستة مؤبّدات.
في الأسر، درس «السامري» العبرية وأتقنها، وشارك في جميع إضرابات الحركة الأسيرة، ومثّلها في التفاوض مع إدارة السجون على انتزاع حقوق الأسرى بالإضراب، إلى جانب دوره القيادي، مع رموز أخرى، في نضال الحركة الأسيرة الذي أرهق إدارة السجون وجهاز «الشاباك» بصلابته، حيث تمكّن من انتزاع حقوق أساسية وضرورات معتبرة، رغم التعرّض لقمع لا إنساني وتعذيب لم ينقطع. وعُرف «السامري» بغزارة قراءاته واهتمامه بتثقيف الأسرى الجدد، وإلقاء المحاضرات حول قضية فلسطين وتاريخها، وبامتلاكه علاقات واسعة وطيّبة مع الأسرى من جميع الفصائل، علماً أنه رافق يحيى السنوار لأعوام في الأسر. كما عُرف بموهبته في الرسم.
التقت «الأخبار» الأسير المحرّر الذي أُطلق سراحه بعد التسوية الأخيرة، وكان – بصفته القيادية ودوره في الأسر، لا بصفته «الدينية» الموروثة – واحداً من أبرز أسماء «أسرى المؤبدات» الذين سعت المقاومة مراراً لإدراجهم في صفقات التبادل، في أحد فنادق أطراف القاهرة الكبرى، حيث يقيم مع الأسرى المُبعَدين. وخلال الحوار، تناول التاريخ – الذي يبدو الرجل من دارسيه المخضرمين – والوضع السياسي، بالإضافة إلى المحطة الراهنة التي تشهدها القضية الفلسطينية.
قاطعت الحوار بين حين وآخر نوبات ألم، قال إنها ناجمة عن كسر ضلعيْن في صدره تحت التعذيب، وهي قيد الفحص الطبي حالياً. واختتم نادر اللقاء بقوله، بنبرة اعتراف مريرة، إنه يستعصي عليه ألّا يشعر بالذنب تجاه الباقين في الأسر، متذكّراً الصمت المطبق الذي ساد السجن، لحظات إعلان أسماء المُفرَج عنهم في الصفقة الأخيرة، ثم الضجة الاحتفالية العارمة عند ذكر رقم زنزانته (12). يعلّق ساخراً بأنه «مدلّل الحركة الأسيرة»، كأنما يرفض استثناء نفسه من النقد. غير أنه يسهل التماس أسباب محبّة الأسرى له من خلال شخصيته الودودة، والأُلفة التي يشيعها حسّه المرح وعفويته مع محدّثه، فضلاً عن أفكاره النقدية اللافتة، المتصلة بقراءاته الغزيرة لأكثر من عشرين عاماً.
1- بعد تواصلنا الأول فكرتُ أن سنوات الأسر العشرين تكاد تلخّص تطور جيل التكنولوجيا الحالي، ولعل أحدث الأدوات الإلكترونية وقت أسرك عام 2004 كان مشغّل موسيقى لم يعد مستخدماً (MP3). اكتشفنا أخيراً أن التكنولوجيا تُستخدم وسيلةً للمراقبة والسيطرة إجمالاً، وللقتل في الجنوب العالمي. ما انطباعك عن تأثير مستوى ودور التكنولوجيا الحالي على الإنسان وأفكاره؟ وهل تشعر (مثل الكثيرين) أن الهاتف الحالي يتجاوز كونه «أداة»؟
أداة ليست كلمة بسيطة، الأحزاب أدوات وكذلك مؤسسات العمل الجماهيري والأهلي. الدولة أداة وكذلك السلطة بقضّها وقضيضها، الإنسان يكون بشكل أو بآخر أداة. سأتجاوز وأقول إن المتلقّي أيضاً يتجاوز كونه متلقّياً. الجهاز مهيمن بحكم أن الإنسان قابل للهيمنة – هيمنة تحديداً وليس شكلاً من السيطرة. وهيمنة الرأسمالية اليوم والقوى الإمبريالية باستخدام التكنولوجيا تعبّر عن قدرة رأس المال على إعادة إنتاج ذاته، ولطالما كانت هذه القدرة ميزة رئيسية يمتلكها، والميزة الأكثر ديمومة والأكثر نفعاً له.
إن كان من خلل في فكرنا جميعاً (كان ولم يزل وأظنه سيبقى) فهو عدم قدرتنا على إعادة إنتاج ذاتنا، وهذا ينبع أساساً من جمود فكري أو الفكر «الخشبي». التكنولوجيا اليوم تبسّط كل شيء، وسيطرت على جيل كامل لدرجة أنه يستمع لها وحدها. قدّموا لي بالأمس «شات جي بي تي»، وسألتُه عني، وقدّم تعريفاً أضحكني، وعن وسيلة لعلاج بحّة الصوت وأجابني مشكوراً، وكان شديد التهذيب حدّ أنه قال: «شكراً على ذوقك» لأنّي شكرته!
القدرة على إعادة إنتاج الذات وفهم الواقع بشكل أسرع، والتعاطي معه بشكل مرن، قدرة يتمتع بها رأس المال، هي قدرة فئة جديدة منه لا على إعادة إنتاج السيطرة وحسب، لكن على ديمومتها. التكنولوجيا اليوم أداة سيطرة ولم تتجاوز كونها أداة، لكن معنى «أداة» ليس هيناً. بمعنى ما ربما كل شيء في العالم أداة، حتى الإنسان. هي تسيطر على الإنسان، وهو نفسه أداة تخدم رأس المال، مثل كون الفكر الرأسمالي كله أداة لخدمة مصالح طغمة، تعمل بدورها أداة لخدمة طغمة أصغر وأقوى. 10% من الناس في العالم يملكون ما يملكه 90%، وفعلياً 3% من العشرة يملكون 97% من الثروة، وهؤلاء يختبئون في الكواليس ونرى عادةً 7%، ووجودهم يجسّد فلسفة حسين مروة ومهدي عامل، وتحديداً الأخير – وإن كانت لغته خشبية مثل ما أنتقد -، عظيم القدرة على شرح فلسفة التناقضات: التناقض الرئيسي والثانوي.
بالمناسبة قبل قراءة مهدي عامل كنت صاحب طفولية يسارية، وأصابني بصدمة. عندما تفهم هذه الفلسفة والتناقض الأساسي، ترى الأخير مع الـ3%. إنه «التناقض الخفي». الاقتصاد، كل شيء في العالم اقتصاد. أو كيف تضع تناقضاً أساسياً ما في الواجهة ويظل خفياً بمعنى آخر، لأن الناس – بمرور الزمن – يتعاطون مع الأساسي «الظاهر» لأنه أسهل. وبعد مقولة أن «الاقتصاد تعبير مكثّف عن السياسة والعكس صحيح»، جاء مهدي عامل وقال إن السياسة تعبير مكثّف عن ذاتها في وجود الاقتصاد: الأخير في الخلفية ويضع السياسة في الواجهة.
الطرف صاحب التناقض الأساسي مع عموم الناس هو صانع التكنولوجيا، وهي ليست اختراعاً يمكن اتخاذ قرار بشأنه، وهي كذلك لا تتطور بقرار، إنما بسياق طبيعي لتصبح جزءاً من بنية الواقع. لا أعرف مدى صدقية مقولة أن تطور تكنولوجيا في عام واحد يسبق وعي الأفراد بثلاثة عشر عاماً، مثلاً استخدمت مؤسسة الحكم الأميركية الإنترنت داخلياً أواخر الثمانينيات، وأدركه أغلب الناس بحلول منتصف التسعينيات؛ في الأسر، من سُجن عام 1975 وحُرر عام 95 رأى اختلاف الهاتف من القرص إلى الأزرار، لكن من سُجن من 95 إلى 2015 أعانه الله! لولا تهريب بعض الهواتف إلى السجن، ولو لم تُعتقل أجيال جديدة صالحَتنا مع الواقع الجديد، ولو نظرياً، لصُدمنا صدمة أكبر.
2- بمناسبة تلك الصدمة، أخبرنا عن وضع الحركة الأسيرة الآن، وهل القمع المطلق الحالي صنيعة الوزير بن غفير تحديداً؟
لم نمسّ أو حتى نرى السكر لآخر عامين، وهذا وحده قاسٍ، ما بالك والملح معه. من قرّر أن الأسرى الفلسطينيين ممنوعون من الملح والسكر؟ شيطان. لكن بن غفير ليس ذكياً، وثمة مغالطة أحياناً في إدراك ما تعرّضت له الحركة الأسيرة تلك الفترة: ما يمارَس هو نتاج عمل لجان أقرّته طوال سنوات، لكنه وُضع جانباً، حتى جاء بن غفير وجمعه وطبّقه. يقسَّم وضع الحركة الأسيرة إلى ما قبل 7 أكتوبر وما بعده، وهذا له وجاهة، «اللي ما انحبسش آخر سنتين ما انحبسش».
لكن، كانت الغاية العليا لإدارة السجن والمؤسسة الأمنية دوماً قمع الجسم الأسير، وتفريغه من محتواه النضالي والإنساني والثقافي. شعرنا بوطأة رغبتهم تلك طوال الوقت، قبل 7 أكتوبر. وفي أكثر الأوضاع «رخاءً»، لكن بشكل منطقي حال بينهم وبين تحقيقها المطلق غياب عنصرين آخرين، يشكلان معها مثلث (الرغبة والقدرة والإمكانية الفعلية).
حضرَت الرغبة في قمعنا دوماً وبكثرة وتزايُد، واحتدّت وفق عوارض مثل الحكومات الأكثر يمينية، أو حدث سياسي متعلّق بالحالة العربية، أو حملة إعلامية على المناضلين الفلسطينيين. وعن القدرة، تبيّن أن لديهم قدرات لم نتخيلها، وكل أدوات تتخيلها لقمع الإنسان. لعامين غسّلنا أسناننا بقطعة جلدية قاسية تبدو مخصّصة للكلاب، وتسبّب نزيفاً فموياً عادةً، فضلاً عن الهراوات، وصنفها الحديدي، والكهرباء والعصي المطاطية وغاز الفلفل، وغاز المسحوق الكيماوي العادي، وصنفه الأقوى، والقيود باختلاف أنواعها. أمّا الإمكانية للقمع فلم تكن دائمة، وحكمتها شروط المناسبات والاحتكاك أو المواجهات مع الإدارة، والأحداث والمصادفات، مثّلت جميعها فرصاً لتحقّقها.
على أنه حال بين إدارة السجن واكتمال هذا المثلث، وتحقيق هدفها بتفريغ مضمون الأسير الثقافي، والتنظيمي بشكل أساسي، فاعلية الحركة الأسيرة. واعتمدت تلك بدورها على عوامل مساندة، الأكثر أساسية فيها كان قدرة الحركة على تثوير الشارع الفلسطيني، دوماً الأول والأساس هو الجماهير، ومن ناحية أخرى لم ترد إدارة القمع التورّط مع المستوى السياسي الإسرائيلي، بأن تسبّب تصعيداً شعبياً، وسط «السيولة» السياسية الكافية لتغيير التحالفات، والتأثر بميول الشارع وقتها، ولعلّنا رأينا ذلك قبل الطوفان وفي عهدَيْ بينيت ولابيد. 5 أو 6 انتخابات في فترة قصيرة، وانقسام عمودي ووضع سياسي يفتقد الحسم. تاريخياً استطاعت الحركة الأسيرة تحريك الفلسطينيين، وكان المسّ بحقوق الأسرى يجلب هبّات جماهيرية فورية يلحقها تفاقم للوضع.
كذلك لعب الجانب القانوني (الإسرائيلي والعالمي) دوراً في تخفيف وطأة الهجوم والمصادرة علينا. انتبه: تسفك إسرائيل كل هذا الدم علناً وتحتاج إلى «غسل» الأمر. لذلك تروّج لتل أبيب عاصمة صديقة للمثلية الجنسية مثلاً. ويقدّمون أنفسهم واحة للديمقراطية بإفساح مجال للعناصر العرب في البرلمان. يتحدثون ويسبّون ويؤذّنون، ويقدّمون نقيضاً وجودياً لـ«الشعب» الإسرائيلي. وبهذا يُظهر أحد أشكال الديمقراطية والقانون، مع تداول السلطة، وكل ما يفتقده العالم العربي. أدّى رفع القضايا والالتماسات للمحاكم الإسرائيلية إلى اصطفاف القانون معنا أحياناً، وساعدنا نسبياً وجود الجسم القانوني المحلي والدولي. بمناسبة المصادرة، للصهاينة قدرة عجيبة عليها، مصادرة حياتنا نفسها. منذ أيام استشهد الأسير محمود طلال بالإهمال الطبي.
العامل الثالث الذي حال دون اكتمال المثلث، وهو فوق الجبين، فاعلية المقاومة، جنوباً في غزة وبدرجة أقل شمالاً في لبنان. أبعدت مقاومة غزة الأنياب عن الحركة الأسيرة طويلاً، وبتشكيل «حركة حماس» و«حزب الله» لبنية عسكرية جيدة لسنوات حقّقا توازناً للرعب، ما أدخل مؤسسة الحكم في توتر أمني. كما عوّدتنا الحالة الإسرائيلية أنها قصيرة النفس، وهو ما تغيّر آخر سنتين. تأمّل كيف يحضر الخلل عند الإنسان: يوم 7-11-2023 وقفت في منتصف الزنزانة، وقلت للشباب لا أعلم كيف مرّ شهر ولم يُطلق سراحنا، لكني أكيد أنه لن يمر شهر آخر! مثل مقولة «تعلّم يا جاهل»، قال لي الواقع «اصبر»، ولم تزل المعركة.
سأكون صادقاً، وضع الحركة الأسيرة سيّئ أخيراً، ربما 70% من الأسرى يفتقدون الاهتمام الثقافي والتنظيمي، ودفعنا ثمن ذلك آخر سنتين وبدت واضحة هشاشة بنية الحركة. توقّعنا ذلك مُسبقاً، لكن آمنّا بأنه في ساعة الاشتباك سيختلف الأمر. صحيح أن التثقيف وقت الاشتباك (على صعوبته) ممكن وضروري، لكن تبيّن خطأ ذلك.
3- انضممت إلى أحد أبرز التنظيمات في تاريخ القضية الفلسطينية، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». بهذه الصفة وبكونك أسيراً محرراً، ما تقييمك للحظة الحالية لمشروع الثورة الفلسطينية (وأنت أحد رموزه)؟ هل مثّلت «أوسلو» مكسباً فلسطينياً؟ وماذا يحتاج الشعب الفلسطيني، سياسياً، مع التفكك الجغرافي لكتله السكانية بالاحتلال؟
أولاً، لا أرى نفسي أحد الرموز. لست سوى أسير بارز في «الجبهة الشعبية». نعم الجبهة عنصر بارز في الحركة الوطنية. وقد يساعد أحد الطرفين الآخر، لكني أقل من أن أكون أحد رموز الحركة الوطنية الفلسطينية. وهناك رموز تستحق التركيز عليها أكثر بكثير في هذا السياق.
الشقّ الثاني يحتاج إلى إجابة صريحة، لأن مشروع الثورة الآن يحتاج إلى تقييم نقدي صريح. الأجدر والأولى أن يكون صريحاً.
هناك عناصر كثيرة في الثورة الفلسطينية أنهت دورها التاريخي بصفتها حاملاً للمشروع الوطني، وباتت الآن «تسربل» مسيرته أكثر من أنها تحمله (في هذه اللحظة التاريخية) إلى الأبعد. تنظيمات لا تعبّر عن كتلة تاريخية شعبية واضحة، ولا تعبّر عن ذاتها كفاية، وأنهت دورها التاريخي حقاً، وهذا قد يستفزّ الكثيرين، لكنّي مستعدّ لنقاش كل من يريد نقاش تلك الحقيقة. قطاع كبير من الأحزاب اليوم يحتاج إلى وقفة صريحة لتقييم الوضع، بشكل أكثر شمولية، ولنعبّر عن ذلك بالإنتاج الفكري.
متى مرّ علينا، نحن المتابعين، آخر إنتاج فكري لتنظيم فلسطيني – يساري تحديداً؟ لقد توقفوا عن الإنتاج الفكري منذ زمن، ما يعني إجهاضاً ذاتياً. أن ينتهي الإنتاج الفكري يعني أن تسمح للفكر بأن يعدو قدماً، وأنت ثابت في مكانك، والثبات في المكان تراجع حقيقةً. ولا أتحدّث عن ثبات عمره سنة أو اثنتان، إنما عقد أو عقدان. توقّف الإنتاج الفكري تعبير عن الأزمة التنظيمية والمالية والسياسية. وهذا السياق «الأزموي» المتداخل، العضوي داخل هذه البنى التنظيمية، دمّرها. ودعوني أكنْ أكثر صراحة. شخوص هذه التنظيمات أكبر من التنظيمات ذاتها. مثلاً عند التعبير عن أسير محرر ينتمي إلى أحدها، يقدّم الكثيرون التنظيم من خلاله، ولا يقدّمونه من خلال إرثه التنظيمي، وهذا دليل عجز وفقر التنظيم.
هناك استعداد مفتوح عند المقاومة لصنع المعجزات
ولنعد إلى الوراء قليلاً، حين دخلت الحالة الفلسطينية في سياق ما سمّاه الاحتلال بالذئاب المنفردة في المواجهة. كان كل شاب، وكل صبية فلسطينية، يسعيان إلى النضال، يخرج أو تخرج إلى الشارع بسكين مطبخ، وأحياناً بمقص خياطة، تعبيراً عن الغضب، وسعياً للاندماج في الحالة النضالية. الذئاب المنفردة لا يمكن توقّع أفعالها، وبالتالي اتخاذ خطوات رادعة. وهذا الفعل، مع كل استعداده النضالي، ومع كل الشكل الرومانسي فيه، إن صحّ التعبير، كان يعبّر بشكل أو آخر عن عجز التنظيمات، ويعني أن استعداد الأفراد للتضحية كان أعلى من استعداد التنظيمات.
هي تنظيمات لم تكن على استعداد لفحص الشارع الفلسطيني، واستخراج العناصر الأكثر استعداداً للتضحية فيه. وهذه مهمتها التاريخية. إن لم تقم بهذه المهمة فما مهمتها إذاً؟ عجزت عن قيادة الشارع في هذا المستوى وعن الارتقاء إلى مستوى تضحيته، ولاحقاً عن التعبير عن ذاتها وتطلعاتها السياسية، في عدة محطات. والأبرز كانت الانتخابات التي دعا إليها محمود عباس، وكانت فضيحة سياسية يستحيل ابتلاعها، لكن كل التنظيمات ابتلعت الطعم. دققنا جدران الخزان حينها، وفي أكثر من محطة. رجوناهم رجاءً: أوقفوا هذه المهزلة، وعودوا إلى الخلف قليلاً، وفكّروا بالأمور بشكل أكثر منطقية. وحينها، اتُّهمنا بأننا عبثيون ونرفع شعارات وحين يأتي موعد تطبيقها نتراجع، وكان هذا مضحكاً وسخيفاً.
لعلّ التنظيمات الفلسطينية تقف بعد 7 أكتوبر، بعد أن تضع الحرب أوزارها، وتقوم بمراجعة ونقد ذاتي لتقيّم أداءها، وتحاكم ذاتها بشكل صحيح. هو أجدى للثورة، وقد يأتي بنتائج تفيد الوضع القادم، لأن معالجته بنفس أدوات الماضي تزيد تدهوره، تحديداً لأن الوضع أخطر من أن نغضّ الطرف عنه، ونكتفي بالقناعة بالممكنات. التعبيرات السياسية والتنظيمية والكفاحية التي تمارسها التنظيمات الفلسطينية اليوم، أعجز من أن تحمل القضية إلى مستوى آخر، أي البقاء في ذات النقطة مع أن الوضع تجاوزنا منذ زمن. «القطار قطع وعدّى» وما نمسكه اليوم ليس سوى غبار مسيرته. وأن ندرك أو نقتنع، عنوةً، أن ما نحمله هو شيء من القطار، هذا سنتحمّل نتائجه لاحقاً.
4- بدت المعركة الأخيرة انطلاقة جديدة للمقاومة الفلسطينية، تفعّل تراكم أوراق القوة في غزة تحديداً، وغيرها، وتطرح ضرورة انتزاع سيادة حقيقية وتقرير مصير، بعد طول تجاهل من النظام الدولي، ومتغيّرات فارقة في الضفة الغربية والإقليم إجمالاً. هل انتهت المعركة؟ وكيف ترى مآلاتها؟ وما أثر إضعاف مقاومة غزة على مواجهة المشروع الحالي للاحتلال؟
كانت المقاومة أمام خيارين: أن تكون محقّة أو تكون ذكية، واختارت أن تكون محقّة. في السادسة والربع يومها كان في يد المقاومة 13 عسكرياً صهيونياً أسيراً، منهم 4 ضباط مخابرات، لو انتهت القصة عند ذلك لاختلف الحدث، لكنها قراءة سطحية للأمور، وخيار المقاومة أن تكون محقّة في حد ذاته خيار ذكي.
كما قلت في بداية السؤال سعت المقاومة إلى فرض أجندة للمستقبل. والمفارقة في 7 أكتوبر أنها نهاية مرحلة وليس بداية مرحلة، وسيتّضح ذلك لاحقاً. نهاية مرحلة توازن الردع والسكوت عن التضخّم العسكري الغزّي، أي صمت الاحتلال عن هذه المعادلة عنوةً أو اختياراً، لكن كان يخبّئ لها ما يخبّئ. ولا يخدع أحد نفسه ويقول إن الحكومة الحالية، التحالف اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل، كان يمكن أن يغادر سدة الحكم ولم يزَل من توازن ردع في غزة، وفي السياق الانتخابي ألمح مراراً إلى تصفية هذا التوازن.
من جهة أخرى، شعر جيش الاحتلال دوماً بامتلاك ما يكفي ويزيد من القوة، وبالتالي قوة «حماس» مردوعة ويمكن الاطمئنان إلى المستقبل القريب، وهذه النظرية كُسرت في السابع من أكتوبر. في ظني 7 أكتوبر كان نهاية مرحلة، كان مخطّطاً انتهاؤها بشكل أو آخر، أن تُنهى أو تنتهي من تلقاء ذاتها، هذا ما وصفته سابقاً بالاختيار بين المُحق والذكي. كان مخطّط تدمير القوة العسكرية للإسلام السياسي، والتنظيمات الفلسطينية إجمالاً، في غزة على الطاولة وتُناقَش آليته التنفيذية. لم يكن السؤال إن كان الاحتلال سيدمّر هذه البنية، إنما متى؟
5- تقصد أنه مُرجّح أن «حماس» (والمقاومة الغزيّة) استشرفت مخطّطاً جاهزاً لضرب تراكم القوة في غزة؟
ليس على قاعدة أنها قرأت الغيب، لكن كل من يمتلك ألف باء التحليل السياسي يدرك أن هذه الحكومة لم تكن لتغادر سدّة الحكم من دون تدمير القوة السياسية في غزة، وكانت غزة الخاصرة الرخوة للاحتلال خلال الأعوام الخمسة المنصرمة، أو العشرة تحديداً. من بعد 2014، وعجز آلة القمع الصهيونية عن إنهاء «حماس»، وبقائها على قدميها ومواصلة الأداء العسكري خلال السنوات العشر، صارت تشكّل حالة ذلّ للصهاينة إذا قلناها «بالمشرمحي».
كأسير كنت شاهداً في عدة محطات على شكل الحوار النضالي مع إدارة السجون. كُنّا نبتزّهم مباشرةً، استناداً إلى غزة، وكان الديدن أن يبلغ الموقف حافة المواجهة، فيتراجع «الشاباص» بحكم ضغط المستوى السياسي؛ إذ يقول الأخير: «أنا مش فاضيلك». كان دخول الحالة المدنية الإسرائيلية في مواجهة وقتها معناه التأثير على الأداء الانتخابي والحكومة، وبالتالي كلفة مدفوعة.
أعود وأقول: ألف باء القراءة السياسية مؤداه أن ما فعلته قوات الاحتلال، بهذا الزمن المكثّف والطريقة الفعّالة والشكل المتواتر، وتجاهل ما يُقال في العالم، كان مخطّطاً ومدروساً على كل المستويات، مستوى التبرير الخارجي والإعلام والفعل الداخلي والميداني، وتحريض الداخل الإسرائيلي على المكوّنات غير اليهودية في المجتمع. كله كان مخطّطاً، ويستحيل أن يصدّق إنسان أن العدو، بحالة الضغط العسكري المكثّف الذي أطلقه، كان ينتقل من خطة إلى أخرى. الخطط لم تتغيّر.
كان واضحاً وجود خط مستقيم يبدأ بنقطة وينتهي بأخرى، يراها المستوى السياسي الإسرائيلي ويعرف إلى أين يصل. بدليل قول غانتس أو غالانت (وزير الدفاع الإسرائيلي حينها)، رداً على أبي عبيدة (حين قال نحن مستعدون لتحمل ستة أشهر من المواجهة المفتوحة)، لا ستة أشهر ولا سنة ولا سنتين.
كان العدو يعرف ما يفعل لأنه امتلك مخطّطاً محدّداً مسبقاً. والإشكالية كانت متى يبدأ التنفيذ؟ لا أستطيع التخمين متى كان يمكن أن يبدأ، ولكن أستطيع التأكيد أن 7 أكتوبر لم يكن السبب، بل العلة تبحث عن سبب. هذه العلة، النقطة التي علّقنا عليها كل شيء، أتت مثلما «إجت العتمة على قد إيد الحرامي» كما تقول «حاجّاتنا». والمراجعة على قاعدة السياق العفوي أو الثأري، أو المنفلت غير المضبوط من المقاومة، وبالتالي المغامر، إجحاف وجلد ذات أتمنى تركه. 7 أكتوبر كان مُسرِّعاً لا أكثر.
عن مواجهة المشروع الصهيوني الحالي، الإشكالية أن على الفلسطينيين الآن لا مواجهته وحده، لكنْ معه مخطّط دولي إمبريالي، كولونيالي عربي غربي، وكأنّ العالم يعيدنا أو يحيلنا تاريخياً إلى المسألة اليهودية وحلها، والبحث عن حلول جذرية من منتصف القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن العشرين، وظهر الحل الجذري بإنشاء الكيان الصهيوني، والحالة عكسية (على كل الصعد) في غزة. الصعوبة في سؤال مواجهة الفلسطينيين للمرحلة الحالية من المشروع الصهيوني، تكمن في أن المواجهة من دون شكل من أشكال المقاومة المسلحة تبدو أمراً غير مسبوق.
6- حفل الإعلام أخيراً، والجدالات في الشارع العربي، بمناقشة مستقبل غزة و«البديل» لحكمها، وسط تداعيات «طوفان الأقصى». من منظور الفكر المقاوم ما البديل؟ وما التعويض المرجوّ عن تراجع القوة الخشنة للمقاومة؟
كما قلت، 7 أكتوبر كان نهاية مرحلة، أي مرحلة التوازن العسكري. لن يسمح الاحتلال بهذه المعادلة مجدّداً، سواء بالتدخل السياسي أو الخشن العسكري، لأن هذا التوازن سبّب للاحتلال مأزقاً. لا تتخيّل مدى التأثير العسكري لغزة على الأرضية السياسية الإسرائيلية. ولم يكن لأحد تصوّر تأثير الانتفاضة الثانية على السيولة السياسية الإسرائيلية. مثلاً إلى حينها كان هناك انقسام أيديولوجي في الشارع الإسرائيلي، بعدها «ساح» الشارع سياسياً على بعضه.
مع السيولة الأحدث، وفشل تجارب ضرب المقاومة تكراراً، تصلّبت نقاط محدّدة في تلك السيولة نتيجة ظهور تيارات يمينية متشدّدة، واجتذابها أكبر عدد من الأصوات «العائمة»، التي تتذمر ولا ترى من يعبّر عنها سياسياً، والتي رأت التعبير الشعبوي الفوضوي الأحمق الذي يمثّله بن غفير. شارع يمنح شخصية مثله ما يقارب الـ 300 ألف صوت، شارع محكوم عليه بالفشل والانتحار السياسي.
واختيار الصهيونية المتطرفة في الشارع الإسرائيلي، خياراً سياسياً بديلاً، اتجاهه واحد من اثنين: إمّا أنها مرحلة «يخوضون بها الوحل»، إذا افترضنا أنه شارع واعٍ، وهذا رهان خطير ويفتقد مقوّمات القراءة السياسية الحقيقية على الأرض. وإمّا أن هذا الشارع يذهب فعلياً نحو التطرف. وأي دارس في التاريخ للكيانية الكولونيالية الاحتلالية العسكرية، التي تتحوّل لاحقاً إلى مجتمع مدني، يدرك تماماً أن مصيرها التطرف حتماً. نتحدث عن مجتمع كولونيالي وليس مجرد «سلطة» كولونيالية، وهذا مصيره التطرف لأن سياقه التحريضي الذاتي في حفظ الذات يقوم على شيطنة الآخر.
حتى تكون القومية سليمة يجب أن تقوم على احترام الآخر في ظل الاعتزاز بالذات، لكن عند حذف الأولى واحتقار الآخر في ظل تقديس الذات، طبيعي الذهاب إلى الفاشية. عندما تعتمد وحدتك الداخلية دوماً على شيطنة الآخر بدايةً، ولاحقاً إضافة ما يريد إلى هذه الشيطنة، التحقير ونزع الآدمية، وإن لم تستطع إثبات ذلك على الآخر تثبت به رقي ذاتك، الذي يتحوّل إلى تقديس للذات. إسرائيل مجتمع كولونيالي، والمجتمعات الكولونيالية محكومة حتماً بالتطرف، ومثلها لن يسمح لمعادلة توازن الردع الفلسطيني بالتشكّل مرة أخرى في الأفق المنظور.
دعني أورد مثالاً: استدعاني من 6 شهر ضابط استخبارات سجن «شطّة»، مع جملة من ضباط «الشاباك». أخبرني عن «جرائم حماس» ضد المدنيين وقدّم لي صوراً، قلت لا يمكن الفخر بما لا فخر فيه، هذه تصرفات مدنية غير منضبطة وواضح أنها غير محترفة. إن أخطأت «حماس» فالخطأ عدم السيطرة عليها. قال هم ناس من «حماس»، فقلت هي تعبيرات شعبية من ناس مخنوقين حاصرتهم بحراً وبراً وجواً لعشرين أو خمسة وعشرين عاماً، مع ضرب متواصل، ولحظتها أمسكوا بك. أنا إن حشرت قطاً بقفص وطاولني سيمزقني، ما بالك بمليون ونصف مليون إنسان؟ ماذا تخيّلت؟ أن يقولوا لك حقّك علينا، «كيفك شو أخبارك»؟ «منيح اللي ما أكلوك».
استُفِزّ الضابط وأكّد أنه مجتمع إرهابي، قائلاً، إن أنفاق غزة أطول من مترو فرنسا. حسبته يقصد باريس، فقال لا، أطول من أنفاق المترو في كل فرنسا. لا أعرف لِم غشيني الضحك، وقلت فرنسا بكل المعدات اللازمة والمتطورة حفرت المترو في البلاد في خمسين أو سبعين عاماً، وهؤلاء الناس حفروا بأظْفارهم أطول منه، بزمن قياسي لا يتعدى 5% من هذا الزمن! «شو قاعد بتسوّي؟ قوم اهرب». فأمر السجّان بإعادتي إلى الزنزانة، ولحقتني وحدة تعذيب. ليلتها تصوّرت خروفاً مذبوحاً في المكان من كثرة الدم الذي نزفت.
كان تحطيم القوة العسكرية للمقاومة الفلسطينية في غزة، هدفاً استراتيجياً ولم يزل قائماً، وسيظل قائماً. وفي المقابل هناك استعداد مفتوح عند المقاومة لصنع المعجزات. وتخيّل أن أضعف حلقات محور المقاومة كانت أكثر الحلقات صموداً؟ من جهة أخرى، علينا احتساب أن تراكم القوة في غزة ليس كمياً وحسب، هو تراكم ذهني، وآليات صناعة الردع التي امتلكتها المقاومة وثّقتها عقول تعلَمها، وتعلم كيفية البدء من جديد، ومن هنا واردة إعادة البناء. ومن جهة أخرى، ليس ما يشغل الطرفين الإسرائيلي والأميركي السلاحُ الخفيف. شعار تجريد «حماس» من السلاح، وهذا هدفهم تحديداً، هو القلق من إمكانية التصنيع في صمت.
7- هناك اتجاه فكري عربي قديم يعيد طرح نفسه ومنطقه الآن، ويقول إن المقاومة خيار غير عقلاني بالأساس، ويدلّل بدمار غزة وتراجع مشروع المقاومة أخيراً. ولعلّك واجهت نفس الفكرة قبل الأسر وفي خضمّ الانتفاضة الثانية. كيف تراها بعد التجربة، وعامين من «طوفان الأقصى» وتداعياته؟
كما قلت أنت ليس هذا جديداً، هي مهاترات قديمة. هناك وجاهة في القول إن المقاومة العسكرية تؤدّي إلى تراجع في العمل السياسي في الحالة الفلسطينية، وتراجع الوضع العام للحالة الفلسطينية. صحيح أن هذا له وجاهة، يرى المشاهد السطحي – بوضوح – أنه كلما زادت العمليات والمقاومة المسلحة على الأرض، تراجع أداء «البنية المدنية الفلسطينية» إن صحّ القول: حضارياً، اقتصادياً، سياسياً، تعليمياً، أكاديمياً، وما نحو ذلك. لكن علينا أن نفكر بشكل منطقي أكثر. هذه وجاهة سطحية.
الصحيح أننا الحالة الفريدة في الثورات الوطنية في العالم، التي ارْتأت ألّا تستثمر العمل العسكري في العمل السياسي، وعلى العكس تدين العمل العسكري في المستوى السياسي. والأخير لا يكتفي بعدم استثمار العمل العسكري بل يدين وينبذ ويشيطن العمل المسلح. لذلك، طبيعي تماماً في حال عدم جني ثمار العمل العسكري سياسياً، أن يصبح العمل نوعاً من الوبال على الأداء السياسي. لكن عندما يكون الأخير ضعيفاً وهشاً ماذا ننتظر؟ إدانة وشيطنة العمل المسلّح ديدن النظام السياسي الرسمي الفلسطيني منذ بدء عملية التسوية. التسوية التي كانت في الأساس تسوية من أجل التسوية. تخيّل أنّك تلعب الشطرنج مع ذاتك ولا تعرف من الغالب!