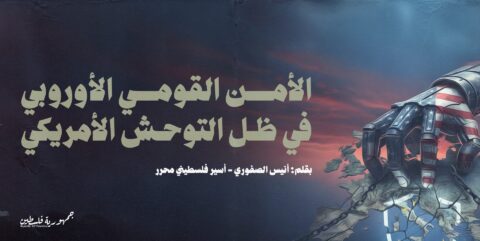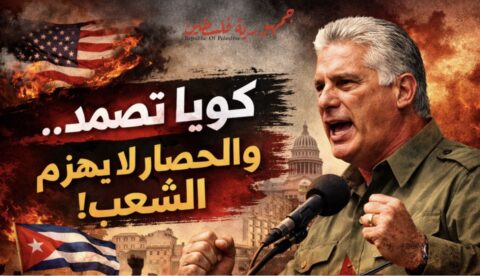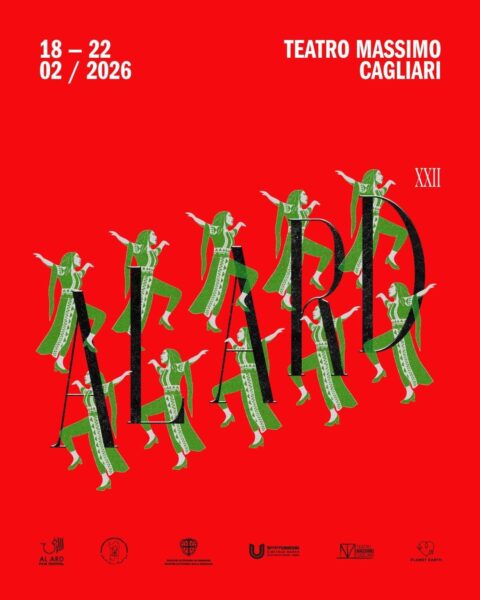حسن شاهين
يمكن أن يُقال الكثير عن هجوم 7 أكتوبر (2023) بين مدح وذمّ وتمجيد وتقريع، ولكن لا مجال للجدال في أهميته ومفصليته، فهو حدثٌ كانت له تداعيات وتوابع كبرى على القضية الفلسطينية أولاً، ثم على موازين القوى الإقليمية، ومن المتوقّع أن تكون له آثار بعيدة المدى في آليات العدالة الدولية التي ثبت مدى ارتباط فاعليّتها بمصالح الدول، ولا سيّما القوى الكبرى. وربما سيؤرّخ في المستقبل لـ”7 أكتوبر” بوصفه حدثاً كان له دور (وإن بشكل غير مباشر) في التأسيس لحقبة جديدة في السياسة الدولية.
ورغم الإقرار بأهمية الحدث المذكور حدثاً تاريخياً، إلا أن من المستبعد أن تكون القيادة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي خطّطت للعملية العسكرية وقرّرت تنفيذها، قد وعت النتائج كلّها التي ترتبت منها، السلبية والإيجابية. فمن الصعب تخيل أنها توقّعت حرب الإبادة الوحشية التي شنّتها إسرائيل على سكّان غزّة، فلو توقّعت ذلك، فالأرجح أنها ما كانت لتقدم على العملية.
هناك أسباب عدة تدفع إلى استبعاد أن “حماس” كانت واعية بالنتائج والتداعيات الكبرى للهجوم، منها أن النتيجة لم تكن في صالحها ولا في صالح المحور الذي تنتمي إليه. ويكفي مقارنة وضع الحركة قبل العملية ووضعها اليوم، وكذلك تراجع مطالبها وموافقتها على ما كانت ترفضه في محطاتٍ عديدةٍ خلال الحرب، وارتباك خطابها، خصوصاً في الأيام الأولى. نذكّر ببيان أبو عبيدة (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) الذي هدّد فيه بتصفية المحتجزين إن استمر القصف الإسرائيلي، فقد كانت توقّعات “حماس” من الطوفان وأهدافها مغايرةً تماماً لما حدث. وعبّر عنها القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمّد الضيف، في بيان صدر بعد ساعات من بدء العملية، كشف فيه أهدافاً واسعةً وكبيرةً منها: رفع الحصار عن قطاع غزّة، وكنس المستوطنات من الضفة، وإنهاء احتلالها، وتبييض السجون، ووقف التعدّيات على المسجد الأقصى، وإنهاء التنسيق الأمني، وتفجير اشتباك شامل مع الاحتلال في الضفة والمناطق المحتلة في 1948، وإنهاء الضربات الإسرائيلية على سورية والعراق، ووقف استهداف القادة.
لا يعني نقد “الطوفان” تحميل “حماس” مسؤولية جرائم إسرائيل، رغم مسؤوليتها الوطنية عن حساباتها الخاطئة
لم يكن خطاب الضيف تعبوياً بقدر ما كان توجيهاً عملياتياً للمعركة، حدّد فيه الأسباب والأدوات والأهداف، وإن لم يكن ذلك في نقاط مفصلة. وكان واضحاً من الخطاب أن “الطوفان” هدف إلى إحداث تغيير شامل في واقع الصراع، تغيير بحجم إلحاق هزيمة استراتيجية بإسرائيل، تجعلها أمام تحدٍّ وجودي. لكن ما حدث بالفعل أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة هو من واجه التحدّي الوجودي، والأهداف التي حدّدها الضيف في بيانه تحقّق عكسها تماماً.
قراءة خاطئة لموازين القوى
تداخلت عوامل متعدّدة شكّلت الظرف الذي دفع حركة حماس إلى تنفيذ عملية طوفان الأقصى. أولها عزلة غزّة، وغياب أفق لفكّ الحصار الطويل عنها، وتهميش القضية الفلسطينية في السياسة العربية والدولية، وهو ما عنى تهميش طرفي الانقسام الفلسطيني معاً. غير أن هذا الواقع استفزّ قيادة “حماس” أكثر ما استفزّ قيادة السلطة، التي تبدو منشغلةً بترتيباتها الداخلية أكثر من أيّ شيء آخر، إضافةً إلى رفض الاعتراف بدورٍ سياسي لـ”حماس”، رغم كل محاولاتها، ومحاولات قوى إقليمية لدعمها. ثمّ جاء تراجع الرئيس محمود عبّاس عن إجراء الانتخابات التشريعية عام 2021، ليحبط أيَّ أمل لدى قيادة
حركة حماس بتغيير هذا الواقع. تلك الانتخابات التي لو أُجريت، ربّما ما كنا شهدنا “7 أكتوبر”.
العامل الثاني الحسابات الخاطئة لـ”حماس” حول العملية، فقد اعتقدت أن أسر جنود ومدنيين إسرائيليين والتحصّن داخل منازل في مستوطنات غلاف غزّة، مع استخدام سكّانها دروعاً بشريةً، سيجبر إسرائيل، ومن ورائها الولايات المتحدة والغرب على التفاوض مع الحركة والتسليم بحكمها غزّة، وربّما الاعتراف بها ممثلاً رسمياً للشعب الفلسطيني.
ولكن لماذا كانت حسابات “حماس” خاطئة بهذا القدر؟… ربّما لأن عوامل عدّة ساهم في سوء تقدير قيادتها الموقف، وبالتالي في وضع حسابات غير واقعية لعملية طوفان الأقصى. من هذه العوامل ما هو موضوعي، مثل عزلة غزّة والجمود السياسي، ومنها ما هو ذاتي يتعلّق بتكوين الحركة الفكري والعقائدي، وبطبيعة القيادة التي اتخذت القرار. وقد جعل تفاعلُ هذه العوامل العقلَ السياسي لـ”حماس” عاجزاً عن إدراك مسألتَين أساسيَّتَين عند اتخاذ قرار “طوفان
الأقصى”:
أولاً: تغيّر موازين القوى في العالم وفي المنطقة تحديداً. فكما أشار المبعوث الأميركي، توم برّاك، بعد عامين تقريباً، لم تعد الولايات المتحدة مهتمة بنفط المنطقة كما كانت، لأنها لم تعد تعتمد عليه مقابل توفير الأمن للدول العربية. وقد جاءت عملية طوفان الأقصى في وقت كانت واشنطن تعمل فيه على بناء نظرية أمن جديدة في المنطقة، وإسرائيل تتهيأ لتكون ركناً أساسياً فيها. ولو أدركت “حماس” ذلك لعلمت أن قواعد الاشتباك السابقة مرشّحة للانهيار.
ثانياً: سوء تقدير سلوك إسرائيل وردّة فعلها على عملية بهذا الحجم، فتصورات شائعة كثيرة لدينا (مثل حساسية إسرائيل تجاه سقوط قتلى مدنيين أو عجزها عن خوض حرب طويلة الأمد) قد تصلح لتوقّع سلوكها في مواجهات محدودة، لكنّها لا تنطبق عندما تواجه حدثاً زلزالياً مثل “طوفان الأقصى”.
هَدُفَ “طوفان الأقصى” إلى إحداث تغيير شامل في واقع الصراع، تغيير بحجم إلحاق هزيمة استراتيجية بإسرائيل
وعلى هذا الصعيد، نبّه القيادي السابق في الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي مبكّراً (2021)، من داخل غزّة، إلى ما سمّاها خفّة قيادة المقاومة، وانفلات خطابها من الضوابط والحسابات، محذّراً من مغامراتٍ قد تدفع إليها أوساط قيادية لإثبات مصداقيتها. يضاف إلى ذلك عامل ذاتي آخر مهم، وهو اعتقاد الحركة وقيادتها بفكر ديني سلفي عرفاني، يجعلها تشعر بأنها مدعومة في كل ما تتصرّف بإرادة إلهية.
لا يعني نقد “طوفان الأقصى” تحميل “حماس” مسؤولية جرائم إسرائيل، رغم مسؤوليتها الوطنية عن حساباتها الخاطئة. كما أن الاعتراف بالتحولات الإيجابية التي أعقبت العملية لا يُعد بأي حال إقراراً بصوابية قرار الحركة. كذلك إن نقد الطوفان والحسابات الخاطئة لا يبرّران بأيّ حال ما ارتكبته إسرائيل من جرائم، فاستهداف المدنيين العزّل، وتعمّد قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم، جريمة تتجاوز بمراحل مبدأ الردّ المتناسب في القانون الدولي. إنها سياسة عارية من أيّ ضوابط قانونية أو إنسانية، تمثل ممارسة متوحشة في زمن اليمين الشعبوي، كما عبّر عنها وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، حين قال، لحظة إعلان تغيير اسم وزارة الدفاع، إلى وزارة الهجوم: “سننتقل إلى الهجوم، وليس الدفاع. أقصى قدر من الفتك، وليس الشرعية الفاترة. تأثير عنيف، وليس صوابيةً سياسية”. وقد جسّدت إسرائيل هذه العبارة فعلياً في سلوكها على مدى العامَين الماضيَّين، بكل ما فيها من ازدراء للقانون الدولي والقيم الإنسانية.
القيادة الفلسطينية: حال بائس وشرعية متحلّلة
أمّا القيادة الفلسطينية الرسمية، فقد فشلت في أن تكون على مستوى التحدّي الوجودي الذي يواجهه شعبها. لم تتخذ خطوات سياسية جادّة، رغم أنها هدّدت مراراً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لأسبابٍ أقلّ بكثير من الإبادة. ورغم أنها الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني المعترف به دولياً، فقد غابت عن تنظيم الحراك الشعبي العالمي الداعم لفلسطين وقيادته، وحتى عن مواكبته. ومن المنصف الاعتراف بجهود بعض الممثلين الفلسطينيين الرسميين في عدة دول، لكن ذلك يبقى استثناءً لا يلغي القاعدة.
لقد مارست السلطة قمعاً لأي تحرك شعبي مساند في الضفة الغربية، مع أن مسؤوليتها الوطنية لا تقتضي السماح بالتظاهر والاحتجاج وحسب، بل أيضاً قيادته وتعبئة الجماهير حوله. لكن يبدو أن انتفاضةً شعبيةً عارمةً في الضفة تُقلق السلطة كما تُقلق إسرائيل. كما غاب دور القيادة الرسمية من الحراك الدبلوماسي الدولي للاعتراف بدولة فلسطين. ففي مؤتمر حلّ الدولتَين، الذي عقد في الأمم المتحدة بمبادرة فرنسية سعودية، كان حضورها أقرب إلى حضور ضيف شرف منه إلى فاعل أساسي. وحتى في قمّة شرم الشيخ لوقف الحرب في غزّة، بدا تمثيلها باهتاً وشكلياً.
لم يكن هذا الأداء الضعيف مفاجئاً، بل نتيجة طبيعية لتآكل الشرعية الذي بدأ منذ أكثر من ربع قرن، وانتهى بابتعاد القيادة عن مصالح شعبها وتطلعاته لصالح لعب دور وظيفي يخدم الاحتلال، وهو ما اعترف به الرئيس محمود عبّاس نفسه. وقد ساهمت هذه القيادة بشكل كبير في الوصول إلى الواقع الراهن، فبعد أن وقعت في فخّ “أوسلو” (1993)، لم تستفد من دروس لبنان والأردن، وأسّست سلطةً فاسدةً تسودها المحسوبية والاستزلام والتكتلات المصلحية، وأفرغت حركة فتح من مضمونها النضالي، وحوّلتها جهازاً يتبع السلطة (وصفها يزيد صايغ أخيراً بأنها جثة تسير على قدمين. رغم قسوة الوصف، إلا أنه يستحقّ التأمل). وكان ذلك، إلى جانب خطأ “حماس” التاريخي بالسيطرة على غزّة، سبباً أساسياً في الانقسام الفلسطيني.
وبعد الانقسام، تجاهلت القيادة كل محاولات إقامة وحدة سياسية على أساس برنامج مشترك كانت قد وافقت عليه سابقاً. وكما ذكرنا، لو لم تتراجع عن انتخابات عام 2021، لما كنّا وصلنا إلى “7 أكتوبر”.
لا يمكن في الحالة الفلسطينية أن يُولد تيار ثالث حقيقي، إلا إذا استند إلى أيديولوجيا تقدّمية علمانية واضحة
تحوّلات إيجابية
وكما أن قيادة حركة حماس لم تكن مدركةً تداعيات “الطوفان” السلبية، فمن المستبعد أيضاً أنها كانت تتوقّع ما نتج منه من تحولات إيجابية ذات طابع استراتيجي. أبرزها: اتساع حركة التضامن الشعبية العالمية مع الشعب الفلسطيني خلال العامَين الماضيين، وتزايد عزلة إسرائيل الدولية بفضل نضال النشطاء في الغرب، الذين دفع كثيرٌ منهم ثمناً له، والضرر الذي لحق بإسرائيل فكرةً ووظيفةً، وهو ما يُفسّر عدوانيتها المفرطة وسعيها المستميت إلى تأكيد قدرتها على لعب دور إقليمي قيادي.
لكن هذا الإفراط في العدوانية جاء بنتائج عكسية؛ إذ ظهرت إسرائيل مصدرَ تهديدٍ لأمن دول إقليمية كبرى، ولأمن الإقليم ككل، خاصة بعد حربها على إيران التي انتهت إلى فشل زاد من الشكوك حول قدرتها على صياغة نظام أمن الإقليم، ثمّ زادت الطين بِلَّةً بقصفها الفاشل لقيادة “حماس” في قطر.
قبل “7 أكتوبر” كانت إسرائيل تنسّق مع الولايات المتحدة والغرب لتكون ركناً في محور يضبط الأمن في المنطقة، أمّا اليوم فقد باتت دول إقليمية تضع شروطها لترتيب الأوضاع في ما يُعدُّ ساحةً داخليةً لإسرائيل، أي غزّة والضفة، فأعلنت الإدارة الأميركية أخيراً أنها لن توافق على ضمّهما لإسرائيل.
الواقع اليوم… وسؤال ما العمل؟
يواجه الشعب الفلسطيني اليوم تحدّياً وجودياً غير مسبوق في كل المحطّات المظلمة التي مرّ بها منذ النكبة، فغزّة مدمّرة وشعبها مكلوم، والضفة الغربية تحوّلت كانتوناتٍ سكّانيةً معزولةً تفصل بينها مئات الحواجز والبوابات، وغول الاستيطان ينهش أرضها يومياً. تعمل إسرائيل بدأبٍ وإصرار على إيجاد البيئة الموضوعية والسياسية التي تمكّنها من ضمّ الضفة الغربية فعلياً. أمّا الشتات الفلسطيني، فقد تراجع تدريجياً ثقلُه السياسي والديموغرافي، وفاعليّته السياسية، خلال العقود الماضية، نتيجةً اتفاق أوسلو، ومتغيّرات أخرى محلّية تخصّ بلدان اللجوء الرئيسة.
التحدّي الوجودي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني يستدعي أن تتحد قواه وفعّالياته ليتمكن من مواجهتها، وقد أثبتت التجربة طوال السنوات العشرين الماضية (على الأقل) أن ذلك لا يمكن أن يترك للمسؤولية الوطنية لحركة حماس والقيادة الرسمية، التي أثبتت التجربة أنها ليست المحرّك الرئيس لسلوكهما السياسي، لذا لا بدّ من دفعهما إلى الوحدة دفعاً، ولكي يحدث هذا لا بد من أن تكون هناك قوة تعلي المصلحة الوطنية وتشكل ندّاً لهما.
لقد شهدت السنوات الماضية محاولات متعدّدة لإنشاء كيانات سياسية جديدة تسعى إلى تجاوز الواقع الفلسطيني الموجود، لكن جميع هذه المحاولات أخفقت، لأنها حملت في داخلها بذور فشلها، فهي ظلّت نخبويةً، ولم تنجح في التحوّل تياراً شعبياً حياً. كما افتقدت الوضوح الأيديولوجي، فظنّت أن الابتعاد عن الأيديولوجيا سيجعلها مقبولةً من الجميع، فكانت النتيجة أن ابتعد عنها الجميع. وأخيراً، لأنها انعزلت عن القوى السياسية القائمة، التي وإن كانت مأزومةً، فإنها لا تزال تمتلك حضوراً وتمثيلاً في الوجدان الوطني.
وقد بات بروز تيار ثالث عقلاني، يتمسّك بالثوابت الفلسطينية ويضغط باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية، ضرورةً ملحّةً أكثر من أيّ وقت مضى، لمواجهة خطر الإبادة في غزّة، ومخططات الضمّ في الضفة الغربية، وتصفية قضية اللاجئين في الشتات، فلم يعد ممكناً الرهان على السلطة و”حماس” وحدهما لإدارة دفّة السفينة الفلسطينية، فكل منهما يريد توجيهها بما يخدم مصالحه الضيّقة، حتى لو أدّى ذلك إلى غرقها.
الوحدة الوطنية الفلسطينية، رغم كل الخلافات، شرط وجودي لشعب لا يمتلك وحدة جغرافية ولا ديموغرافية
ولا يمكن في الحالة الفلسطينية أن يُولد تيار ثالث حقيقي، إلا إذا استند إلى أيديولوجيا تقدّمية علمانية واضحة. وعند تشكيله، ينبغي إطلاق حوار جادّ مع قوى اليسار الفلسطينية للعمل على إنشاء جبهة عريضة يجمعها برنامج تقدّمي ديمقراطي، يزاوج بين أفكار اليسار في العدالة الاجتماعية ومبادئه النضالية، وبين قيم الليبرالية في المساواة والحرية والعلمانية، مع التمسّك الصارم بالثوابت الوطنية الفلسطينية المعروفة. ولنا في تجربة الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا نموذجاً يمكن الاحتذاء به، فالقوى المُشكِّلة للجبهة حافظت على وجودها المستقل، لكنّها توحّدت في إطار يحمل القواسم المشتركة فيما بينها.
يتطلّب هذا من قيادات اليسار تقديم تنازلات تاريخية وشخصية، وهي مسؤولية يجب أن يواجهوها بشجاعة. فوجود قوى اليسار في قلب هذه الجبهة يعني امتلاكها (الجبهة) أدوات العمل الميداني من كوادر ومنظمات شعبية وغيرها، ويُسهم في تجاوز مشكلة النخبوية التي أضعفت كل المحاولات السابقة.
ومن شأن هذه الجبهة أن تستقطب بسرعة قطاعات واسعة من جماهير الشعب الفلسطيني. ويكفي التذكير بتجربة تحالف الجبهة الشعبية مع أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، في الانتخابات الرئاسية عام 2005، حين حصل البرغوثي على نحو %20 من الأصوات. وعندما خاض الاثنان الانتخابات التشريعية لاحقاً بقائمتين منفصلتين، لم تتجاوز نسبتهما معاً %6.5، وهو ما يبرهن على أهمية الوحدة في التأثيرين الشعبي والسياسي.
تشكيل هذه الجبهة العريضة شرط أساس لدفع الحالة الفلسطينية نحو الوحدة، فلا وحدة ممكنة طالما استمرّ استفراد القيادة الرسمية و”حماس” بالساحتين السياسية والشعبية من دون وجود قوة موازنة لهما، فالوحدة الوطنية الفلسطينية، رغم كل الخلافات والانقسامات، شرط وجودي لشعب لا يمتلك وحدة جغرافية ولا ديموغرافية، وتبقى وحدته السياسية في منظّمة التحرير بعد إصلاحها وإعادة بنائها هي الضمانة الحقيقية للحفاظ على حقوقه، والكيان الشرعي الذي يمتلك الحق في النضال لاستعادتها.